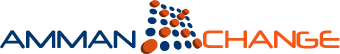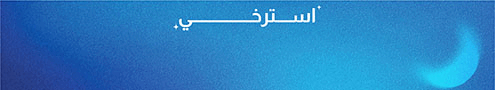المواضيع الأكثر قراءة
- هل يعاد النظر بالعبء الضريبي على قطاع الإسكان؟
- جاهزية سدود المملكة تحت المجهر الفني
- تركز الاقتصاد الوطني في قطاع الخدمات يكشفه أمام الصدمات الخارجية
- توجه لتنفيذ 5 مشاريع تعنى بالبيانات في إستراتيجية التحول الرقمي
- مسارات التحديث.. ملامح البرنامج التنفيذي الثاني
- الأطر القانونية والإستراتيجية للتوقيع الرقمي (3-1)
- العقبة.. تحول إستراتيجي نحو مركز جذب سياحي واقتصادي واعد
الاقتصاد الأخضر وكفاءة استخدام الموارد*د. أيوب أبودية

الراي
يُعدّ الاقتصاد الأخضر نموذجًا اقتصاديًا بديلًا يُعطي الأولوية لاستدامة الموارد البيئية الطبيعية، ويهدف إلى تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية التقليدية. من بين المبادئ الأساسية لهذا النموذج تحسين كفاءة استخدام الموارد في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الصناعة والزراعة والتعدين، وصولاً إلى قطاعات النقل والإسكان والطاقة والسياحة. وبدلًا من التركيز على تعظيم الإنتاج بأي وسيلة، يركز الاقتصاد الأخضر على تعظيم النفع البيئي والاجتماعي من الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر والتلوث بزيادة كفاءة الإستخدام.
من أبرز مداخل الاقتصاد الأخضر هو التحوّل نحو ما يُعرف بـ"الاقتصاد الدائري"، والذي يقوم على إعادة تدوير الموارد، وإعادة تصميم المنتجات بحيث تدوم لفترة أطول، وإعادة استخدامها أو إصلاحها بدلًا من التخلص منها. هذا التحول لا يحافظ فقط على الموارد الطبيعية، بل يقلل من الاعتماد على توسيع عمليات التعدين والزراعة، التي تُعد من الأنشطة الملوثة للبيئة الطبيعية بمكوناتها.
فمثلا في اليابان، برزت مدينة كاواساكي كنموذج عالمي في تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري بعد أن كانت مركزًا صناعيًا تقليديًا يواجه مشاكل بيئية خطيرة في منتصف القرن العشرين، فشرعت المدينة منذ التسعينيات بتطبيق سياسات مبتكرة لتقليل النفايات الصناعية، وتشجيع التعاون بين الشركات لتبادل النفايات واستخدامها كمواد أولية فيما بينها.
وتبادل النفايات أو المخرجات الفائضة من العمليات الصناعية هو ما يُعرف بـ"التماثل الصناعي"، حينما تتحول نفايات مصنع إلى مدخلات لمصنع آخر. هذه الاستراتيجية سمحت لدولة متقدمة مثل اليابان بخفض كمية النفايات بشكل جذري، وتقليص الحاجة إلى الموارد الأولية المستخرجة بالتعدين، والتي هي نادرة في اليابان أصلا. وبإمكان وزارة البيئية استحداث دائرة للتنسيق بين المصانع لتحقيق هذه الغاية.
ومن الأمثلة الأخرى، تبنّت اليابان مفهوم "المجتمع الدائري" على المستوى الوطني، وهو مفهوم يسعى إلى تقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، مثل المعادن، وزيادة نسبة إعادة التدوير، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والحد من انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة الأخرى عبر تغيير أنماط الحياة والأكل والتسوق والسياحة والتنقل وغيرها.
أما في أوروبا، فتُعتبر هولندا من الدول الرائدة في تبني سياسات الاقتصاد الأخضر والدائري. فقد أعلنت الحكومة الهولندية عن استراتيجية طموحة للوصول إلى اقتصاد دائري بالكامل بحلول عام 2050. ولتحقيق هذا الهدف، تشجّع هولندا الشركات على إعادة تصميم منتجاتها لتكون قابلة للتدوير بالكامل، وتستخدم النفايات كموارد بديلة عن التعدين. ففي قطاع البناء، على سبيل المثال، يتم تفكيك المباني بطريقة تُمكّن من إعادة استخدام بعض مكوناتها، بدلاً من هدمها بالكامل وإرسالها إلى مكبات النفايات.
ويشكّل التعدين أحد المصادر الرئيسية لتدمير البيئة في العالم، فهو يسبب إزالة الغابات وانجراف التربة، وتدمير المواطن البيئية، وتلوث التربة والمياه والهواء. كذلك، فإن عمليات الاستخراج وإعادة التكرير تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، وتنتج كميات كبيرة من الغازات الدفيئة والمياه الملوثة بالسموم، مما يسهم في تغير المناخ وتدمير الموائل الطبيعية. من هنا، فإن تقليل الحاجة إلى التعدين من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد يعد من أهم مكاسب الاقتصاد الأخضر، خاصة في البلدان النامية حيث مراعاة الأنظمة البيئية مرنة.
وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، فإن إنتاج طن واحد من الألمنيوم المعاد تدويره يستهلك 5% فقط من الطاقة المطلوبة لإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام. وفي حالة النحاس، فإن إعادة التدوير توفر نحو 85% من الطاقة مقارنة بالإنتاج الأولي. ناهيك باجتناب الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي الهائل. وهذا ما يوضح الأثر البيئي الايجابي الكبير للتدوير وأهمية خفض نشاطات التعدين.
وفي الدول النامية، لا يزال التوسع في التعدين يرافقه ضعف في الرقابة البيئية، وفساد إداري، وتأخير في التنفيذ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التلوث وفشل الاستثمار وتدهور صحة المجتمعات المحلية وتلوث المياه الجوفية. لذلك، فإن تبني نموذج الاقتصاد الأخضر ليس فقط خيارًا بيئيًا، بل ضرورة صحية وإنسانية بالغة الأهمية.
مثال آخر من المغرب، حيث يُعدّ قطاع الفوسفات من أكبر مصادر الدخل القومي، إذ تمتلك البلاد أحد أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، وتديره "المكتب الشريف للفوسفات" (OCP). ورغم التقدم الصناعي، فإن بعض المناطق المنجمية القديمة مثل "خريبكة" و"اليوسفية" تعاني من آثار بيئية خطيرة نتيجة الإهمال وسوء التخطيط البيئي في العقود الماضية.
وقد تُركت مناجم قديمة مكشوفة ومليئة بالمخلفات الكيميائية لعقود دون تأهيل أو معالجة، ما تسبب في تسرب المواد الضارة إلى التربة والمياه الجوفية، وأثّر على صحة السكان المحليين وغطاء الأراضي الزراعية. ويشير ناشطون بيئيون إلى وجود تقاعس رسمي في إلزام الشركات بإعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء العمليات، ويُرجع البعض ذلك إلى الفساد الإداري أو تضارب المصالح بين الجهات المسؤولة.
هذا المثال يبيّن كيف أن غياب الشفافية وضعف الرقابة البيئية في الدول النامية يمكن أن يحوّل الموارد الطبيعية من نعمة اقتصادية إلى كارثة بيئية وصحية، ويعزز الحاجة لتبني الاقتصاد الأخضر القائم على إعادة تأهيل المواقع المتضررة، وتشديد قوانين التعدين، وربط الاستثمار بالمحاسبة البيئية.
ويُشجّع الاقتصاد الأخضر أيضًا على تحويل الهدر إلى فرصة استثمار. ففي قطاع الزراعة، على سبيل المثال، يمكن استخدام المخلفات العضوية كسماد طبيعي أو كوقود حيوي، بدلًا من حرقها أو طمرها. ففي إفريقيا، بدأت مشاريع تستخدم قشور البن ومخلفات الذرة لإنتاج الطاقة الحيوية. هذا التوجه يحدّ من اعتماد القرى على الفحم النباتي، ويقلل من نشاط إزالة الغابات والتلويث. وفي بلادنا هناك فرص كبيرة لاستثمار جفت الزيتون مثلا.
وفي قطاع الموضة وتصميم الأزياء، الذي يُعد من مصادر التلوث الصناعي عالميا، ويعزى له نحو 10% من الانبعاثات الكربونية العالمية ، أي أكثر من قطاع الطيران والشحن البحري مجتمعين. فضلا عن استهلاك هائل للمياه، حيث يُنتَج القميص القطني الواحد باستخدام آلاف اللترات من الماء.
ومن منظور أوسع، يعكس الاقتصاد الأخضر تحولًا في النظرة إلى العلاقة بين الإنسان والطبيعة. لم تعد البيئة تُعتبر مجرد "مورد" يُستنزف، بل نظام حي متكامل يجب احترامه. هذه الرؤية تتقاطع مع الفلسفات البيئية الجديدة التي تُعيد التفكير في أسس الاقتصاد، من خلال إدخال مفاهيم مثل "البصمة البيئية"، و"العدالة المناخية"، و"الحق في مستقبل مستدام".
وبناء عليه، لم يعد من الممكن تجاهل التدهور البيئي الناتج عن الأنماط الاقتصادية التقليدية. إن تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل التلوث، والتقليل من التعدين، وإعادة التدوير ليست مجرد خيارات تقنية، بل خطوات استراتيجية نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة. فالتجارب الرائدة في اليابان وهولندا وغيرهما تُظهر أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ممكن وفعّال، لكنه يتطلب إرادة سياسية، واستثمارًا في الابتكار، وتغييرًا في السلوكيات الفردية والجماعية.