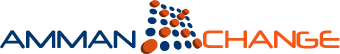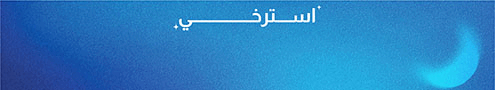المواضيع الأكثر قراءة
- مبيعات "الكهرباء الوطنية" ترتفع 3 %
- التجارة العالمية تحافظ على صمودها غير أنها تشهد تباطؤا حادا في الأوقات الحالية
- 20.6 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة
- ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% والفقراء يواجهون انعدام الغذاء
- خـبـراء: تحول نوعي لتحقيق أمن غذائي وطني مستدام
- اختتام مشروع «الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية
- «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تتصدر طموحات الاستثمار الأجنبي
لماذا لا تهمني نسبة البطالة العامة؟*د.عدلي قندح

الدستور
كاقتصادي، قد يبدو غريبًا أن أقول إن نسبة البطالة العامة لا تهمني كثيرًا، رغم أنها واحدة من أكثر المؤشرات الاقتصادية تداولًا في التقارير الرسمية والخطاب الإعلامي. لكنها فعليًا، في السياق الأردني تحديدًا، رقم مضلل إن لم يُقرأ بعين تحليلية دقيقة، خاصة حين يُقارَن بنسبة البطالة بين الأردنيين.
كاقتصادي، أعلم أن نسبة البطالة المنشورة في الخبر الصحفي لدائرة الإحصاءات العامة هي نسبة البطالة بين الأردنيين، وأن النسبة العامة للبطالة (التي تشمل الأردنيين وغير الأردنيين) أقل منها بفارق يتراوح بين أربع إلى خمس نقاط مئوية. لكن هذا الفارق، برأيي، لا يحمل أهمية كبيرة في سياق تحليل البطالة الحقيقي في الأردن، وذلك لعدة أسباب موضوعية وهيكلية تتعلق بخلل واضح في بيانات سوق العمل.
ولا أنكر أن نسبة البطالة العامة مهمة على المستوى الكلي، وتُستخدم في التحليل الاقتصادي العام والمقارنات الدولية، وقد أشار إلى ذلك بدقة الصديق العزيز الدكتور يوسف منصور في مقال له بصحيفة الرأي، وهو تحليل صحيح من زاوية الاقتصاد الكلي. لكن عند تحليل الواقع المحلي ووضع السياسات التشغيلية، فإن الأهم هو معدل البطالة بين الأردنيين ونسبة مشاركتهم الاقتصادية، لأنها تمس جوهر التحدي التنموي والاجتماعي في الأردن.
الخلل الأكبر الذي يجعلني أُقلل من أهمية نسبة البطالة العامة هو الاختلال الصارخ في نسبة النشيطين اقتصاديًا بين الأردنيين وغير الأردنيين. تشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية بين الأردنيين منخفضة جدًا (38.4 ٪)، مقابل 52.8 ٪ بين غير الأردنيين. وهذا فارق كبير يعكس أن جزءًا ضخمًا من الأردنيين في سن العمل غير منخرطين أساسًا في سوق العمل، لا كعاملين ولا كباحثين عن عمل، أي أنهم غير محسوبين ضمن قوة العمل أصلًا، وبالتالي لا يدخلون في معادلة احتساب البطالة.
من هم هؤلاء؟ هم فئات واسعة ومتنوعة: أولًا، الطلبة في المدارس والجامعات، والذين لا يبحثون عن عمل بعد. ثانيًا، ربات البيوت، اللواتي لا يُحتسبن كباحثات عن عمل، إما لأسباب ثقافية أو لغياب فرص العمل المرن أو خدمات دعم المرأة العاملة. ثالثًا، أشخاص ذوو إعاقات أو أمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على العمل في ظل غياب بيئات عمل دامجة. رابعًا، يائسون من العثور على وظيفة، وقد تخلّوا عن البحث، وهؤلاء رغم أنهم في جوهرهم عاطلون، إلا أنهم لا يُحتسبون كعاطلين لأنهم لا يبحثون عن عمل حاليًا.
في المقابل، نجد أن غير الأردنيين الموجودين في الأردن هم في الغالب قدموا لأجل العمل، أي أنهم نشيطون اقتصاديًا بطبيعتهم، إما يعملون فعليًا أو يبحثون عن عمل، وبالتالي ترتفع نسبة مشاركتهم وتنخفض نسبة بطالتهم الظاهرة.
عندما نأخذ في الاعتبار هذا الفرق في التركيبة السكانية والنشاط الاقتصادي، يتبيّن أن نسبة البطالة العامة لا تعكس الواقع الحقيقي للبطالة بين السكان المحليين. بل يمكن القول إنها تحجب حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردنيون، لأنها تدمجهم في رقم واحد مع فئة مختلفة كليًا في خصائصها وأهداف وجودها في الأردن.
فهل من المنطقي أن نأخذ معدل بطالة منخفضًا لغير أردنيين نشطين بطبيعتهم، ونُخفي به معدل بطالة مرتفعًا لأردنيين يعانون من انسداد آفاق العمل؟ وهل يمكن أن نستند إلى هذا المعدل العام في وضع السياسات، دون أن نُدرك أن ثلثي الأردنيين تقريبًا في سن العمل لا يشاركون أصلًا في السوق؟
البطالة ليست مجرد رقم نطرحه في بيان صحفي أو مقارنة دولية. إنها مرآة لفاعلية النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي برمته. حين يكون أكثر من 60 ٪ من الأردنيين غير نشطين اقتصاديًا، فهذه ليست مجرد مسألة بطالة، بل مؤشر على أزمة عميقة في الحافز، في العدالة، في الثقة، وفي الخيارات المتاحة.
لذلك، لا يهمني كثيرًا أن تكون نسبة البطالة العامة 16.6 ٪، أو أنها انخفضت 1 ٪ عن الربع السابق، طالما أن البنية التي تُنتج هذه الأرقام مشوهة. ما يهمني هو: لماذا الأردنيون يعزفون عن سوق العمل؟ لماذا البطالة بين الشباب والخريجين في ارتفاع؟ لماذا يُفضّل البعض الهجرة أو الجلوس في البيت على خوض تجارب العمل المتاحة؟ لماذا يسيطر غير الأردنيين على قطاعات بعينها؟ وهل هذا بسبب فجوة المهارات، أم ضعف الأجور، أم غياب الحوافز؟
التركيز على نسبة البطالة العامة يُشبه وضع مكياج على وجه يعاني من ندوب عميقة. قد يبدو مقبولًا على السطح، لكنه لا يُغيّر الحقيقة.
ما نحتاجه هو تفكيك بنية سوق العمل، وفهم جذور العزوف، وإصلاح العلاقة بين التعليم والعمل، وتحفيز الأردنيين على الانخراط في السوق بكرامة وأمل.
لهذا، لا تهمني النسبة العامة بل تقلقني الحقيقة المغيّبة خلفها.