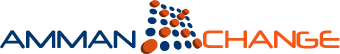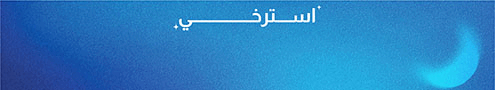المواضيع الأكثر قراءة
- قرارات التحفيز.. خطوة إيجابية ومطالبات بالمزيد
- عقاريون: عودة المغتربين تنعش سوق الشقق السكنية
- حسّان: مؤشرات مُشجعة للاقتصاد الوطني
- باول: «الاحتياطي الفيدرالي» سينتظر مزيداً من البيانات قبل خفض الفائدة
- قيمة صفقات التركز الاقتصادي في السعودية تتجاوز 61.8 مليار دولار
- 14.3 % ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
- 100 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد الشهر الماضي
فرصة أردنية تاريخية لتحقيق أمن الطاقة*جواد عباسي

الغد
نحن في الأردن امام فرصة تاريخية لتكون كل طاقتنا الكهربائية محلية المنشأ ورخيصة للغاية خلال اقل من 8 سنوات أساسها خليط كهربائي متجدد _مع حلول تخزين_ وحمل ثابت يعتمد الصخر الزيتي) والغاز الأردني عندما يزيد انتاجه).
بداية نظرة لواقع النظام الكهربائي الوطني في 2024 بحسب الأرقام الرسمية لشركة الكهرباء الوطنية. في 2024 بلغت الاستطاعة التوليدية في الأردن 7271 ميجاواط منها 1200 ميجاواط لأنظمة شمسية مربوطة على شبكات التوزيع مشكلة نسبة 17 % من اجمالي الاستطاعة. فيما شكل الصخر الزيتي 6 % من الاستطاعة التوليدية (470 ميجاوات) والأنظمة الشمسية المربوطة على نيبكو 14 % والرياح 9 %. فتكون الاستطاعة التوليدية من الطاقة المتجددة 39 % من الإجمالي بينما شكلت الاستطاعة التوليدية المعمتمدة على مصادر محلية 45 % من الإجمالي.
فيما يخص حجم الطاقة المنتجة من الاستطاعة التوليدية شكل الصخر الزيتي 16 % من اجمالي الطاقة المشتراة من نيبكو في 2024 وشكلت الطاقة المتجددة التي اشترتها نيبكو 18 % من الاجمالي.
تقديرا فان الطاقة المستهلكة من الأنظمة المربوطة على شبكات التوزيع (والتي لا تشتريها نيبكو) شكلت 11 % من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن سنة 2024. هذه الطاقة تستهلك أساسا بنفس مواقع انتاجها على اسطح البنايات السكنية والتجارية والصناعية.
وعليه نستطيع ان نقدر ان الطاقة الكهربائية المحلية (صخر زيتي وشمي ورياح) شكلت حوالي 40 % من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن سنة 2024. فيما كان الغاز الطبيعي المستورد مسؤولا عن حوالي 59 % من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الاردن.
الأسئلة:
أولا:- أنظمة الطاقة الشمسي بآلية التصدير الصفري. ما سبب التأخر في ترخيصها؟
صدر نظام رقم 58 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ربط الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي في آب 2024. وفي النظام حل رائع لموضوع استطاعة شبكات التوزيع يسمى آلية التصدير الصفري: حيث يسمح للمنزل بتركيب نظام طاقة شمسية مع نظام تخزين ويمنع من تصدير أي كيلواط لشبكة التوزيع. وهكذا لا يؤثر ابدا على ثبات نظام التوزيع.
في ظل انه قد مر على اصدار هذا النظام عشرة شهور كاملة كم نظام تصدير صفري صار مرخصا في الأردن؟ فنحن نسمع من الشركات العاملة بقطاع الطاقة المتجددة عن تعنت غريب من قبل شركات التوزيع في السماح بهذه الأنظمة مع انها اصبحت قانونية. فهل تضع شركات التوزيع عراقيل غير منطقية خصوصا مع انتشار العدادات الذكية التي تسمح بمراقبة الأنظمة لحظيا؟ من هذه العراقيل مثلا اشتراط قطع الكهرباء عن المنزل عندما تنقطع كهرباء شركة التوزيع! على الرغم من أهمية بطاريات التخزين لاستمرار التزويد الكهربائي للمنزل عند انقطاع كهرباء شركة التوزيع.
بين يدي عرض لنظام شمسي صفري التصدير مع بطاريات التخزين يولد سنويا 8000 كيلواط بكلفة 3800 دينار (قبل المفاصلة!). وعلى فرض انه سيعمل فقط لمدة 12 سنة فكلفة الكيلواط تكون اقل من أربعة قروش لكل كيلواط وهي ارخص من ارخص شريحة منزلية مدعومة واقل من نصف كلفة الكهرباء الحالية على نبيكو. أي انه جذاب ماديا لكل مشترك منزلي يريد ان يوفر كلفة و /أو يقلل تلوث و / أو يساهم في استقلال الأردن في قطاع الطاقة.
ولأن من مصلحة المستخدم ان يستهلك كل ما ينتج سنرى الناس تزيد من استهلاك الكهرباء مثل التحول للتدفئة بالكهرباء والتحول للسيارات الكهربائية وجدولة استهلاك الكهرباء للغسيل والكوي والجلي وقت الشمس لضمان استهلاك اعلى نسبة من الكهرباء الرخيصة النظيفة المنتجة محليا من سطح المنزل. فندخل في دورة نشطة حميدة من نمو في كهربة القطاعات وتخضير مصادر الكهرباء مع زيادة الاستثمار المحلي في الطاقة البديلة وخلق فرص عمل لآلاف المهندسين والتقنيين في هذا القطاع الواعد.
وهناك سؤال آخر لشركات التوزيع: أنَسِيَتْ هذه الشركات المتعنتة في موضوع الأنظمة ذات التصدير الصفري ان رخصها مع الحكومة تضمن لها ربحا ثابتا مربوط بحجم استثمارها في الشبكة ولا يعتمد أصلا على حجم الكهرباء المباعة عبرها؟ هل نحتاج ان نشرح هذا للمهندسين في تلك الشركات الذين يضعون عوائق غير منطقية امام فرصة تاريخية للطاقة الشمسية في الأردن.
هل نسينا ان بلدنا شمسه ساطعة 330 يوم في السنة وحاليا أسعار هذه التقنية الارخص تاريخيا خصوصا مع الصراع التجاري الأميركي الصيني؟
ثانيا:- الصخر الزيتي الذي اثبت نجاعته. لما لا نتوسع باستخدامه؟
على الرغم من الكلفة العالية لمشروع العطارات الذي بات يولد حوالي 15 % من حاجة الأردن من الكهرباء فإن المشروع مهم جدا لانه اثبت نجاعة وكفاءة التوليد من الصخر الزيتي. ولنتذكر ان الكلفة العالية للمشروع كان من أسبابها رفض الحكومات تحمل بعض من مخاطر مشروع يبنى لأول مرة من ناحية نوعية الصخر الزيتي في المنجم. الكلفة المتوقعة حاليا ستكون اقل من نصف الكلفة الحالية لمشروع العطارات حيث إن الكلفة مقاربة لكلفة الإنتاج من الفحم.
وبعد أن اشتغلت محطتا توليد العطارات لعدة سنوات وتم ربط المنطقة مع شبكة الكهرباء الوطنية وبات هناك خبرة محلية وافرة في استخراج الصخر الزيتي وتكسيره وحرقه لإنتاج الكهرباء، ما المانع من اطلاق مناقصة عالمية لكل الشركات المؤهلة لبناء محطات إضافية لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بقدرة اجمالية ألف الى 1200 ميجاواط تحتاج إلى 5 او 6 سنوات لتكون جاهزة؟ فتصل القدرة التوليدية من الصخر الزيتي الى اكثر من 1600 ميجاواط تولد 40 الى 50 % من حاجة الأردن من الكهرباء بعد سنة 2030.
وهذا الخليط الذي يعتمد الى حد كبير على توربينات دوارة في محطات الصخر الزيتي سيساهم في ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية: هندسيا فإن القصور الذاتي في سياق توليد الكهرباء يشير إلى قدرة المولدات على مقاومة التغيرات في تردد الشبكة الكهربائية عند حدوث تغييرات مفاجئة في توليد أو استهلاك الطاقة. هذا القصور الذاتي يعتمد على الكتلة الدوارة للمولدات المتصلة بالشبكة، وكلما زادت هذه الكتلة زادت قدرة المولد على الحفاظ على استقرار التردد.
في هذه الظروف الجيوسياسية لربما أيضا يجب التركيز على تسويق هذه المناقصة امام الشركات الأميركية فتكون محطات توليد الكهرباء من الصخر الزيتي المستقبلية باستثمارات أميركية ونمسك العصا من النصف بين العملاقين الصيني والاميركي!
ما بين بعض من طاقة الرياح وكثير من الطاقة الشمسية والصخر الزيتي سيكون خليط الطاقة الكهربائية في الأردن محليا بالكامل ورخيصا ويوفر علينا استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الغاز. واذا ما نجحنا في زيادة انتاج الغاز الأردني في السنوات القادمة فيمكن أيضا استخدامه في توليد الطاقة عير المحطات القائمة التي تعتمد الغاز بدلا من احالتها على التقاعد عند انتهاء عقودها وزيادة كهربة القطاعات وتصدير الكهرباء. لكننا يجب ان نتحوط ضد إمكانية عدم وصول انتاج الغاز المحلي الى ما نحتاجه وطنيا. وههنا يأتي الدور المحوري للصخر الزيتي المتوفر والذي اثبت فعاليته ونجاعته.
السؤال الأخير يتعلق بقطع الغاز.فالاخبار تبين ان حكومة الاحتلال قطعت التصدير من حقل ليفثيان بينما استمر حقل تمار بتزويد الغاز لتوليد الكهرباء عندهم. مع ان حقل ليفثيان ابعد بحوالي 40 كم الى الغرب من تمار. فهل تتجه الحكومة الى المطالبة بتعويضات مهمة عن هذا القطع الخبيث النية؟
لنتجه بثقة نحو استقلال تام في قطاع الطاقة الكهربائية والا سنجد انفسنا مهددين دوما بقطع او كلف عالية ومعرضين بشكل كبير لتقلبات الجيوسياسة الإقليمية.