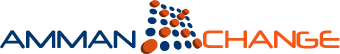المواضيع الأكثر قراءة
- "زين" ترفع تصنيفها في القائمة العالمية للتصدّي لتغيّر المناخ إلى المستوى A
- 9 % ارتفاع طلبات رخص محطات شحن المركبات الكهربائية
- %2 تراجع واردات النفط العراقي للمملكة
- استقرار التضخم خلال العامين الماضيين
- دعوات لاعتماد سياسات واضحة لضمان استدامة الشركات العائلية
- واشنطن تقود تحركاً دولياً لكسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة
- توقعات بتحسن أداء القطاع السياحي عقب تمديد إقامة الأجانب
الإدارة العامة: أزمة أداء تتجاوز الطقس والظروف*جهاد المنسي

الغد
مع أول منخفض جوي في كل شتاء، تعود إلى الواجهة المشاهد ذاتها: شوارع تغرق بالمياه، أنفاق تُغلق، حركة مرورية مشلولة، وخدمات أساسية تتعطل، مشهد بات مألوفًا للمواطنين، لكنه في الوقت نفسه مقلق في دلالاته، ورغم أن الهطولات المطرية في الأردن موسمية ومتوقعة، ولا يمكن تصنيفها في معظم الأحيان كحالات طارئة أو استثنائية، إلا أن تكرار هذه الصور عامًا بعد عام يطرح سؤالًا أعمق من مجرد تقلبات الطقس، ويعيد فتح ملف الإدارة العامة وأدائها.
لم يعد ما نشهده حدثًا عابرًا أو ظرفًا مفاجئًا، بل مؤشر على اختلالات في أسلوب التخطيط والتنفيذ والمتابعة داخل عدد من المؤسسات الخدمية، فالقضية لا تتعلق بكمية الأمطار بقدر ما تتصل بغياب الاستعداد المسبق، وضعف الصيانة الوقائية، وتغييب مفهوم إدارة المخاطر بوصفه جزءًا أصيلًا من العمل العام، لا إجراءً يُستدعى بعد وقوع المشكلة.
الإدارة العامة، بوصفها العمود الفقري للأجهزة التنفيذية، تواجه تحديات تتجاوز نقص الموارد أو ضغط الظروف، فالمعضلة الأساسية تكمن في نمط إداري تراكم عبر سنوات طويلة، تشابكت فيه الاعتبارات الشخصية والمناطقية والشللية، على حساب معايير الكفاءة والإنجاز، هذه الممارسات، وإن لم تكن دائمًا ظاهرة للعلن، إلا أن نتائجها تنعكس بوضوح على جودة الخدمات المقدمة، وعلى مستوى ثقة المواطن بالمؤسسات العامة.
تشير المخرجات الإدارية خلال المرحلة الماضية إلى فجوة واضحة بين التخطيط والتنفيذ؛ خطط تُعلن، وإستراتيجيات تُحدّث، وبرامج إصلاح بعناوين مختلفة، فيما تبقى أدوات التنفيذ على حالها، دون تطوير حقيقي في الآليات أو الكوادر، الأخطر من ذلك أن ثقافة التقييم والمساءلة ما تزال محدودة الأثر، ما يسمح بتكرار الأخطاء ذاتها دون تصويب جاد، ويحوّل الإخفاق من استثناء إلى نمط متكرر.
وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد أكثر الملفات كاشفة لهذا الخلل، إذ يُفترض أن تكون شبكات تصريف مياه الأمطار، وصيانة الطرق، وإدارة البلديات، ضمن أولويات العمل خلال فصول الجفاف، لا أن تُترك رهينة ردود الفعل بعد وقوع المشكلة، وفي كل مرة، يُطرح السؤال البديهي ذاته: أين كانت الصيانة في الصيف؟ وأين خطط الاستعداد في الخريف؟ فلا نجد إجابات مقنعة بقدر ما نجد تبريرات جاهزة.
المسألة هنا ليست تقنية فحسب، بل إدارية بامتياز، فالإدارة الرشيدة تُقاس بقدرتها على التنبؤ والوقاية، لا بالاكتفاء بإدارة الأزمة عند وقوعها، وعندما يتكرر الخلل في المواقع ذاتها، وبالطريقة ذاتها، فإن المشكلة تكون في أسلوب الإدارة ومنهجها، لا في الحدث نفسه ولا في الظروف المحيطة به.
الأزمة، في جوهرها، أعمق من ملف خدمي أو مؤسسة بعينها؛ فهي تعكس فلسفة إدارة عامة ما تزال، في بعض مفاصلها، تنظر إلى الموقع الوظيفي باعتباره منصبًا إداريًا، لا مسؤولية عامة خاضعة للمساءلة، ومع غياب مؤشرات أداء واضحة، وربط الاستمرار بالموقع لا بالإنجاز، يصبح تحقيق نتائج مختلفة أمرًا بالغ الصعوبة.
ولا يمكن، للواقعية والإنصاف، فصل هذا الواقع عن النقاش الأوسع حول التحديث السياسي والإصلاح الاقتصادي، فنجاح أي سياسات عامة، مهما بدت طموحة، يبقى مرهونًا بقدرة الجهاز الإداري على التنفيذ بكفاءة وشفافية، إذ إن إدارة عامة ضعيفة تعني بالضرورة سياسات محدودة الأثر، حتى وإن كانت النوايا حسنة.
الإصلاح الإداري الجاد لا يحتمل مزيدًا من المعالجات الشكلية أو المؤقتة، المطلوب مراجعة جادة وشاملة تعيد الاعتبار لمعيار الكفاءة، وتعزز ثقافة التقييم والمساءلة، وتربط المسؤولية بالنتائج، إلى جانب شجاعة الاعتراف بمواطن الخلل والبناء على الدروس المتراكمة، بدل إنكارها أو الالتفاف عليها.
في المحصلة، ما نعيشه ليس أزمة طقس، بل اختبار متكرر لقدرة الإدارة العامة على التخطيط والاستجابة، وإذا لم يُكسر هذا النمط، ستبقى المشاهد ذاتها تتكرر، وستتآكل معها ثقة المواطن. أما الانتقال الحقيقي، فيبدأ بالتحول من إدارة ردّ الفعل إلى إدارة الفعل الاستباقي، ومن إدارة الأزمة إلى إدارة التنمية المستدامة، وهو الاختبار الحقيقي لأي مشروع إصلاحي جاد.