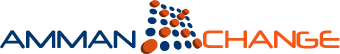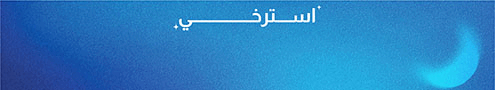المواضيع الأكثر قراءة
- توقع استقبال 2026 بانخفاض في أسعار المحروقات
- المؤشرات الاقتصادية في 2025 ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو
- أسر تعول على العام الجديد لتغيير نمط سلوكها الاقتصادي
- وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة
- مليارا دينار حجم الإنتاج القائم بقطاع الصناعات الهندسية
- هل تعود سورية بوابة العرب الزراعية لأوروبا؟
- مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي
نظرة الشريعة للمخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية

الدستور
تمثل المخاطر هاجساً حاضراً في كل تصرف مالي، والتقلبات الاقتصادية والاضطرابات المالية تبدو في ازدياد على الرغم من محاولات أساطين المال والاقتصاد إيجاد صيغ وعقود وسلوكيات للتقليل من هذه المخاطر .
وتبذل المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي والمنتجات الإسلامية جهوداً في هذا السياق كبيرة
ومتسارعة من أجل إيجاد صيغ ومنتجات لمعالجة هذه المخاطر وإدارتها بما يقلل من آثارها.
وقد أجريت عدة دراسات وعقدت ندوات وورش عمل حول المخاطر، سواء على مستوى التأصيل أو على مستوى التطبيق .
اكد ذلك د. صالح بن عبدالله بن حميد وقال من المعلوم أنه لا ينفك النشاط الاقتصادي، بل الحياة كلها، من التعرض للمخاطر، فالمخاطر كالمشقة والمفسدة، فكما أنه لا يوجد عمل خال من المشقة والمفسدة، فكذلك لا يوجد عمل بشري خال من المخاطرة، غير أن المخاطر في المعاملات والتجارات إذا كانت في حدود المعقول فإنها تؤدي وظيفة ظاهرة في توجيه الحوافز ورفع الكفاءة الإنتاجية، لكن إذا زادت عن الحد المعقول فإنها تهدد استقرار الأسواق وثروات الأمة
فالأصل أن الخطر غير مرغوب فيه كالمشقة، أو هو نوع من أنواع المشقة التي لا تراد لذاتها، وإن كانت لا تنفك عن الأعمال المشروعة.
والمخاطرة هي التعرض لاحتمال الهلاك أو التلف، وقد تكون بالنفس أو بالمال. وهي نوعان:
– ممدوحة، وهي تحمل نتائج الاستثمار من ربح أو خسارة في التجارة، وهذه المخاطرة لابد منها في كل تجارة ، وهذا القسم يعبر عنه الفقهاء بالضمان، ويطلق عليه المخاطرة الإيجابية.
– ومذمومة: وهي المخاطرة التي يكون فيها تعريض المال للهلاك والتلف بأحد العقود المحرمة، كما لو كان في العقد غرر فاحش أو ميسر أو مجازفة لإهلاك المال، ويطلق على هذا النوع: المخاطرة السلبية.
يقول شبخ الإسلام ابن تيمية: «الخطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله في ذلك، فهذا لابد منه للتجار (…) فالتجارة لا تكون إلا كذلك. والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه الله ورسوله.
وهناك نوعان من الخطر: خطر مرتبط بالمعاملات الاقتصادية العادية، أي الأنشطة التي تضيف قيمة أو توجد ثروة؛ والخطر الثاني هو الخطر المرتبط بأكل المال بالباطل، أي بالأنشطة ذات المبلغ الصفري، حيث لا توجد ثروة إضافية صافية (ينظر: التحوط في التمويل الإسلامي، للدكتور سامي السويلم).
والخطر بالنسبة للمنفعة كالمشقة بالنسبة للمنفعة، فالخطر والمشقة غير مقصودين في ذاتهما، إنما المقصود هو المنفعة التي قد لا تنفك عن خطر أو مشقة.
ومن الضوابط الإسلامية في المخاطر: تحريم الربا، تحريم ربح ما لم يضمن، تحريم الغرر، وتحريم القمار.
وبه يتبين أن المخاطر غير المرتبطة بالملكية، أي ليست ناشئة عنها ولا مصاحبة لها، فهي ممنوعة، فتبادلها – أي هذه المخاطر – من الغرر والميسر المحرم شرعاً، فتحريم الربا يمنع حصول الربح دون تحمل مسؤولية في العمل التجاري والصفق في الأسواق، وهذا من معاني ربح ما لم يضمن.
ففي الإسلام لابد أن يتحمل جميع الأطراف المشاركة في المسؤولية في النشاط الحقيقي للعملية التجارية والاقتصادية، ويتجسد ذلك حين يكون الخطر مرتبطاً بملكية السلع والخدمات والمنافع اللازمة للكسب وتوليد الثروة وإدارة التجارة.
وفي الربا والغرر والقمار والمعاملات المشتملة على ذلك كله تجعل المخاطر سلعة مستقلة، أي تكون سلعة متداولة بهدف الربح، وهو ما يعرف في المصطلح الاقتصادي بالمعادلة الصفرية، أي أحد الطرفين رابح والآخر خاسر، ولا يشتركان في احتمال الربح والخسارة.
ولهذا فإن الضمان المستقل عن الملكية لا تجوز المعاوضة عليه لأنه غرر بإجماع الفقهاء.. والربا تجريد للملكية عن المخاطر، والميسر تجريد للمخاطر عن الملكية، ولهذا فإن المعاوضة على الخطر مجرداً، أي المعاوضة على الضمان بثمن ممنوع بالإجماع لأنه من الغرر المحرم. ومثله المعاوضة على الأجل أو الزمن استقلالاً فهذا محرم بالإجماع أيضاً لأنه عين الربا المحرم بالنص، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، والباطل أي دون مقابل حقيقي.