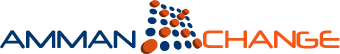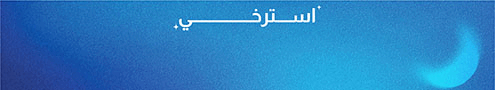المواضيع الأكثر قراءة
- العقبة: استياء من مشروع "بيع الأراضي بالسعر المدعوم
- ضعف الوعي يحرم العمال تعويضات أمراض مهنية
- الدولار يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط مخاوف تجارية والإغلاق الحكومي الأمريكي
- بوتين: نحقق التوازن في أسواق النفط العالمية ضمن «أوبك بلس»
- ميران من «الفيدرالي»: نمو الاقتصاد الأميركي مرتبط بحل التوترات مع الصين
- «ترانسنفت»: الشركات الروسية لم تُخفّض إمدادات النفط
- الذهب يتجاوز الـ 4300 دولار للمرة الأولى وسط تنامي التوترات بين الصين وأميركا
ضعف الوعي يحرم العمال تعويضات أمراض مهنية

الغد-هبة العيساوي
تشهد قضية الأمراض المهنية في الأردن اهتمامًا متزايدًا في ظل ما تكشفه المعطيات من ضعف في التشخيص والتبليغ عن الحالات، رغم وضوح الإطار القانوني الذي ينظمها ضمن قانون الضمان الاجتماعي.
فبينما ينص القانون على وجود 58 مرضًا مهنيًا تُعامل إصابة العامل بأي منها كإصابة عمل كاملة الحقوق، ما تزال هذه الحالات نادرة التسجيل نتيجة غياب الوعي الكافي بين العمال وأصحاب العمل، وضعف الفحوص الطبية الدورية ونقص الكوادر المتخصصة في الطب المهني.
ويؤكد خبراء أن مواجهة هذه الفجوة تتطلب حملات توعية وطنية، وتفعيل التفتيش الطبي والصناعي لضمان حماية العمال، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإهمال في التشخيص المبكر.
ضعف التطبيق
وفي هذا الشأن، رأى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أنَّ مشكلة عدم تشخيص الأمراض المهنية في الأردن بشكل دقيق لا تعود إلى غياب النصوص القانونية، بل إلى ضعف التطبيق العملي على أرض الواقع، موضحًا أنَّ غالبية الحالات التي تنتج عن طبيعة العمل أو عن التعرض لعوامل ضارة في بيئة العمل لا تُسجَّل رسميًا كأمراض مهنية، إما بسبب تأخر التبليغ عنها أو لغياب التوثيق الطبي والمهني اللازم لإثبات العلاقة بين المرض والعمل.
وأضاف أبو نجمة إنَّ العديد من أصحاب العمل لا يقومون بالتبليغ عن الإصابات أو الأمراض المهنية خشية تحمّل المسؤولية أو ارتفاع تكلفة الاشتراكات، في حين أن العامل نفسه غالبًا لا يدرك أن مرضه قد يُعتبر مرضًا مهنيًا يستحق عليه التعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنَّ القدرات الفنية للأطباء واللجان الطبية المختصة بربط الحالة المرضية بعوامل التعرض المهني، ما تزال بحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل، لافتًا إلى أنَّ الفحوص الطبية الدورية التي تُعدّ أداة أساسية لاكتشاف الأمراض المهنية لا تُجرى بانتظام في معظم المنشآت، خصوصًا الصغيرة منها أو تلك التي تتغيّر فيها العمالة بشكل متكرر.
وبيّن أنَّ مؤسسة الضمان الاجتماعي تتعامل مع حالات الأمراض المهنية ضمن إطار تأمين إصابات العمل، حيث تُحال الحالات بعد التبليغ إلى اللجان الطبية المختصة لتقييم مدى مطابقتها للجدول الرسمي وتقدير نسبة العجز، ومن ثم يُمنح المصاب حقوقه الكاملة من علاج وبدلات وراتب اعتلال في حال وجود عجز دائم.
وأضاف إن المؤسسة طوّرت آليات إلكترونية للتبليغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، إلا أن مستوى التبليغ ما يزال محدودًا ويحتاج إلى رفع الوعي بين العمال وأصحاب العمل.
وأوضح أبو نجمة أن القطاعات الأكثر عرضة للأمراض المهنية تشمل الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والزراعة والنقل والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالفحوص الطبية الدورية متفاوت، إذ يتركز في المنشآت الكبرى بينما يبقى ضعيفًا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل النسبة الأكبر من سوق العمل.
وأكد أبو نجمة ضرورة إطلاق حملة وطنية شاملة بالتعاون بين مؤسسة الضمان ووزارة العمل والجهات النقابية والمهنية للتوعية بالأمراض المهنية وحقوق العمال، مشددًا على أنَّ التوعية تسهم في رفع معدلات التبليغ المبكر وتطوير الثقافة الوقائية في أماكن العمل، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال خفض نسب العجز وتحسين الإنتاجية.
واعتبر أنَّ تعزيز الوعي والفحوص الدورية وتفعيل التفتيش الطبي والصناعي هو الطريق الأمثل لضمان ألا تبقى الأمراض المهنية في الأردن خفية رغم حضورها الواقعي في مواقع العمل.
غياب الوعي
من جهته، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن موضوع الأمراض المهنية في الأردن من القضايا المهمة التي ما تزال تعاني من ضعف الوعي والتشخيص، رغم أن قانون الضمان الاجتماعي يتضمن جدولاً خاصًا بـ58 مرضًا مهنيًا، تُعامل الإصابة بأي منها كإصابة عمل كاملة من حيث الحقوق التأمينية والعلاج والرعاية الطبية.
وأضاف الصبيحي إن المرض المهني يُعتبر إصابة عمل إذا أصيب به العامل المؤمن عليه نتيجة عمله في مهنة أو قطاع محدد من القطاعات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، موضحًا أن هذا الجدول هو المرجع الرسمي الذي يحدد أنواع الأمراض المهنية، وليس الجدول رقم (2) كما يُعتقد أحيانًا.
وبيّن أن من أبرز هذه الأمراض الجمرة الخبيثة (الأنثراكس) التي تصيب العاملين في معالجة الصوف والجلود والشعر الحيواني، والماء الأزرق في العين الذي قد يصيب عمال الزجاج نتيجة تعرضهم لوهج الزجاج المذاب، إضافة إلى الأمراض الناتجة عن الراديوم وأشعة إكس التي تصيب العاملين في مجالات التعرض للإشعاعات، وتغبر الرئة الناتج عن التعرض لغبار مادة السيليكا في المناجم والمحاجر، وغيرها من الأمراض التي يصل عددها إلى 58 مرضًا مهنيًا مدرجًا في القانون.
وأشار إلى أن ضعف التوعية بين العمال وأصحاب العمل يعد من أهم أسباب عدم تسجيل أو اكتشاف الحالات، فالكثيرون يجهلون أن القانون يعترف بهذه الأمراض ويمنح المصابين بها حقوقًا تأمينية كاملة، كما أن غياب الفحوص الطبية الدورية في المهن التي تتضمن مخاطر مهنية يُسهم في تأخر التشخيص، لافتًا إلى أن هذه الفحوص نادراً ما تُجرى في القطاعات ذات العمالة المتغيرة أو المنشآت الصغيرة.
وأوضح أن قلة الأطباء المتخصصين في الطب المهني تمثل تحديًا آخر أمام تشخيص الحالات، مؤكدًا ضرورة أن تقوم اللجان الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عند فحص أي حالة مرضية بربط المرض بمهنة المصاب، لأن العامل قد يراجع اللجنة باعتباره مصابًا بمرض طبيعي، في حين أن مرضه قد يكون مهنيًا ناجمًا عن طبيعة عمله.
وبيّن الصبيحي أن اللجان الطبية في الضمان هي الجهة المخولة بتقدير ما إذا كان المرض مهنيًا أم لا، وتحديد نسبة العجز الناتجة عنه، مشيرًا إلى أن بعض الأمراض تحتاج إلى فترات طويلة من العمل قد تمتد إلى عشر أو خمس عشرة سنة حتى تظهر أعراضها، بينما تظهر أمراض أخرى في مدد أقصر تبعًا لطبيعة المهنة.
وأضاف إن العامل المصاب بمرض مهني يستحق كامل المنافع التأمينية في حال ثبوت العلاقة بين المرض والعمل، فإذا أدت الإصابة إلى عجز دائم نسبته 30 % فأكثر، يُمنح العامل راتب عجز جزئي أو كلي، أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك واستمر العامل في عمله، فيُمنح تعويضًا من دفعة واحدة وفقًا لأحكام القانون.
وختم الصبيحي بالقول إن الظاهرة المقلقة هي أن أعداد الحالات المسجلة رسميًا كأمراض مهنية ما تزال منخفضة جدًا، إذ لم تُسجل في عام 2024 سوى أربع حالات فقط من أصل آلاف إصابات العمل المعلنة، وهو ما يعكس حجم الفجوة في التوعية والفحوص الطبية والتشخيص المهني، داعيًا إلى توسيع نطاق التثقيف والتدريب والرقابة الطبية لضمان أن تأخذ الأمراض المهنية موقعها الحقيقي ضمن نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.
مفارقة صادمة
من جهته، أكد خبير السلامة والصحة المهنية فراس الشطناوي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي يعترف صراحةً بوجود الأمراض المهنية ويمنح المصاب بها حق التعويض والرعاية الطبية، لكن الواقع يكشف مفارقة صادمة، إذ تمر مئات الحالات كل عام دون أن تُسجَّل كأمراض مهنية، بل تُعامل كأمراض عادية، فيُحرم العامل من حقوقه، ويُعفى صاحب العمل من مسؤوليته، وتتحمل الدولة التكلفة النهائية دون أن يعرف أحد أين وقع الخلل.
وأضاف الشطناوي أنَّ المشكلة ليست في النص القانوني، بل في التطبيق، فعند لحظة التشخيص تتعطل المنظومة، لأن أغلب الأطباء في القطاعين العام والخاص غير مدرَّبين على الطب المهني، وبعضهم لا يعرف حتى جدول الأمراض المهنية رقم 1 الملحق بقانون الضمان، والطبيب العام ينظر إلى الحالة من زاوية طبية بحتة لا مهنية، فإذا جاءه عامل يعاني من التهاب رئة بعد سنوات عمل في مصنع إسمنت، قد يسجل الحالة كالتهاب عادي، متجاهلاً أن العامل يستنشق الغبار يومياً.
ورأى أن هذه الفجوة في وعي الكوادر الصحية هي البوابة الأولى لضياع الحقوق وعدم تقييم الواقع الفعلي للأمراض المهنية.
وتابع: "هناك أيضاً ضغوط غير معلنة، فكثير من أرباب العمل لا يرغبون في تسجيل أي حالة كإصابة عمل لاعتقادهم أنها سترفع نسب الاشتراكات عليهم وتضعهم تحت رقابة الضمان ووزارة العمل، والعامل يقع في حيرة بين المطالبة بحقه أو الحفاظ على لقمة عيشه، فيختار الصمت."
وأشار إلى أن الفحوصات الطبية الدورية، وهي الأداة الذهبية للكشف المبكر عن الأمراض المهنية، شبه غائبة رغم أن القانون يفرضها، فيما تكتفي غالبية المنشآت الكبيرة بفحوص شكلية لتجنب المخالفات، والنتيجة أن أمراضاً مهنية تتطور بصمت حتى تتحول إلى عجز دائم، فتضيع العلاقة بينها وبين بيئة العمل.
وقال الشطناوي: "اللجان الطبية في الضمان متخصصة، لكنها تعتمد على ما يقدمه الطبيب الأولي وتقارير جهة العمل وسجل التعرض. وإذا لم تُوثق القصة المهنية منذ البداية، يصبح من الصعب إثبات أن المرض مرتبط بالعمل، ويقع عبء الإثبات على العامل، كما لا توجد قاعدة بيانات وطنية لرصد الأمراض المهنية وتحليل أنماطها، ما يعني أننا لا نعرف حتى حجم المشكلة الحقيقي."
وأضاف: "القطاعات الأكثر عرضة للإصابات طويلة، كالمناجم والمحاجر، ومصانع الإسمنت والأسمدة، والصناعات الكيميائية، ومحطات الطاقة، والمخابز، والمستشفيات، وحتى المكاتب، فالأمراض المهنية ليست فقط غباراً وسموماً، بل تشمل أيضاً آلام الرقبة والظهر، والاضطرابات العضلية، والإجهاد البصري، والضغط النفسي، والعدوى، والغريب أن بعض هذه القطاعات لديها أنظمة سلامة، لكنها تركز على الحوادث الفورية كالسقوط والانفجار، وتتجاهل الأمراض البطيئة، أما القطاع الصحي، فهو من أكثر القطاعات تعرضاً للعدوى والأمراض العضلية، ومع ذلك يبقى وعي العاملين بحقوقهم منخفضاً، وتُعتبر الفحوص الدورية رفاهية."
وأوضح أن "القطاع الصغير والمتوسط هو الحلقة الأضعف، إذ لا توجد فيه فحوص أو تدريب أو رقابة تُذكر."
وأكد الشطناوي أن "السؤال الجوهري اليوم هو: هل ننتظر أن يطالب العامل بحقه وهو لا يعرف أصلاً أن الربو المهني أو فقدان السمع أو التهاب الجلد يُعتبر قانونياً إصابة عمل؟ الحقيقة أن أغلب العمال في الأردن لا يعرفون أن المرض المهني يمنحهم نفس حقوق الحادث المفاجئ، وهنا تظهر الحاجة إلى تحرك وطني حقيقي، لا مجرد منشور توعوي."
وقال: "يجب على مؤسسة الضمان والجهات الرقابية أن تنتقل من منطق دفع التعويض بعد الضرر إلى منطق منع الضرر قبل وقوعه، والحملة الوطنية الشاملة ليست رفاهية، بل استثمار إستراتيجي، والتوعية يجب أن تشمل العمال، والأطباء، وأصحاب العمل، والمفتشين، واللجان الطبية، وحتى الجامعات التي تُخرّج أطباء لا يعرفون شيئاً عن طب العمل."
وختم بالقول: "الضمان الاجتماعي سيستفيد مالياً لاحقاً من هذه الحملة أكثر من أي جهة أخرى، لأنه يدفع ثمن المرض بعد أن يتفاقم، بينما يمكن منعه أو اكتشافه في بدايته. ومع أن الضمان أطلق سابقاً حملات تتعلق بالسلامة المهنية، إلا أن الأوان حان لإطلاق حملات متخصصة بالصحة المهنية، فالمشكلة ليست أن القانون ضعيف، بل لأن ثقافة الاعتراف بالأمراض المهنية غائبة، ونحن نجيد التعامل مع الحوادث السريعة، لكننا نفشل في رؤية القاتل البطيء، والسؤال الذي يبقى: هل الخلل في النص، أم في من لا يريد أن يراه كي لا يتحمل المسؤولية؟".