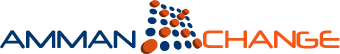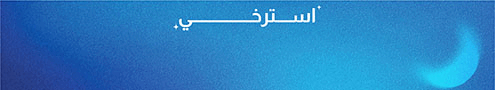المواضيع الأكثر قراءة
- زيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك.. هل تكفي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية؟
- تحديات قطاع الإسكان في إربد على طاولة مجلس النواب
- ارتفاع موجودات "استثمار الضمان" إلى 17.3 مليار دينار
- تعزيز الذكاء الاصطناعي يقلص تأثيرات الهجمات السيبرانية
- كتاب علمي جديد حول التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بمشاركة نخبة من الخبراء
- عقاريون يطالبون بتقديم حوافز لإنعاش القطاع
- تخفيض التمويل الأميركي يهدد وظائف منظمة العمل الدولية
أزمة المياه.. هل من أفق للحلول؟*تمارا خزوز

الغد
«المملكة تمر بأزمة غير مسبوقة، إذ إن حصة الفرد السنوية من المياه لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى المعدلات عالميا، ما يضع الأردن في مقدمة الدول الأشد فقرا مائيا على مستوى العالم.»
تصريح مقلق أطلقه قبل أشهر وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، كان من المفترض أن يثير حالة استنفار وطني على المستويين الرسمي والشعبي، غير أن ذلك لم يحدث. بل على العكس، الحياة تمضي كالمعتاد صيفا فيما «المي مقطوعة يا أفندي!».
الدكتور إلياس سلامة، أستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، أطلق تصريحا هو الآخر –بحسب موقع عمّان نت– أشد خطورة كونه باحثا ومختصا، حذر فيه من «أن الأردن سيواجه خمس سنوات حرجة جدا حتى يكتمل مشروع الناقل الوطني للتحلية، وأكدّ على صعوبة الوضع حتى مع هطول الأمطار، وأن أي تأخر يعني مصيبة مائية.»
ليست هذه المرة الأولى التي نسمع فيها تحذيرات بخصوص الوضع المائي، لكنه يتفاقم مع مرور السنوات. أذكر أنه قبل أكثر من عشر سنوات أعددت ورقة سياسات عامة كجزء من متطلبات برنامج الماجستير بإشراف أستاذي الدكتور باسم الطويسي. تضمنت الورقة مقابلات معمّقة مع الدكتور إلياس سلامة، والدكتور أنور البطيخي، ووزير الزراعة السابق عاكف الزعبي، وكانت الإجابات آنذاك تدور حول المعضلة ذاتها.
تفاقم الوضع يمكن أن يُترجم بالأرقام؛ فقد تراجعت حصة الفرد المائية، بحسب وزارة المياه والري، من نحو 100–130 مترًا مكعبًا سنويا في 2015 إلى ما يقارب 60 مترًا مكعبًا فقط حاليًا. بالمقابل، لم يطرأ أي تحسّن يُذكر على نسبة الفاقد المائي في الشبكات فالرقم الذي يُتداول رسميًا في السنوات الأخيرة هو حوالي 50 %، رغم كل الجهود والخطط المعلنة لخفضه من قبل الجهات المعنية. بالإضافة إلى أن ملف الاعتداءات على المياه ما يزال حاضرا إلى اليوم، رغم تشديد العقوبات.
معادلة الزراعة ومساهمتها في الناتج المحلي كانت حاضرة بقوة في موضوع البحث، وكان هناك شبه إجماع من قبل الخبراء على أن المعادلة غير متوازنة، وعلى ضرورة مضاعفة العائد الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه يُستهلك في الزراعة، من خلال إعادة النظر في الأنماط الزراعية المستخدمة.
من المفارقات في التصنيف الزراعي، أن المحاصيل تصنف بين ما هو شعبي وما هو استراتيجي؛ الملوخية مثلًا، الطبق الأشهر على موائد الأردنيين، تُعتبر محصولًا شعبيًا، بينما يُعتبر التمر والزيتون والنباتات العطرية والطبية كالزعتر والميرمية من المحاصيل الإستراتيجية؛ بمعنى أنها أعلى ربحية وأقل استهلاكًا للمياه. وبرغم وجود دراسات مفصّلة — ومنها دراسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عام 2004 التي وضعت خرائط كاملة للمحاصيل الإستراتيجية — استمرت الزراعة التقليدية في استنزاف الموارد. المشكلة إذن ليست تقنية فقط، بل ثقافية وسلوكية أيضًا؛ تبدأ بالتمسك بمحصول معين، ولا تنتهي بالاعتداء وسرقة المياه لاستخدامها في ري المحاصيل أو لأغراض أخرى.
وبالانتقال من السياسات إلى السياسة، فلنترك الأولى للمختصين، تبرز أزمة المياه كقضية سياسية بامتياز، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الاعتداءات القادمة على الموارد المائية من دول الجوار. وكنت قد طرحتُ سابقًا تصورًا أن حزب «القضية» لا «البرنامج» هو الأقدر على الانتشار بين قطاعات واسعة من الناخبين، لكونه أوضح في معالمه وأكثر قربا من وعي وهم المواطن، بما يمنحه فرصا أكبر للاستقطاب. غير أنّ الموجة الدارجة آنذاك كانت موجة الأحزاب البرامجية!
قضايا مثل أزمة المياه الحادة في الصيف، والاعتداءات على شوارع وأرصفة العاصمة مرتبطة حُكمًا بهمّ المدينة والمواطن، فلماذا لا نشكّل حزبًا من أجلها!