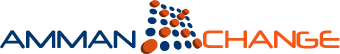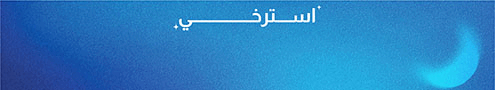المواضيع الأكثر قراءة
- البنك الدولي: "برنامج المهارات" يوفر 51 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات
- "الطاقة" تواصل استكشاف العناصر الأرضية النادرة في الجنوب
- الإصلاحات النقدية المستمرة توفر بيئة مالية مستقرة وتعزز ثقة المستثمرين
- تزايد الإقبال على تعويض "الدفعة الواحدة" يضعف تمكين المرأة اقتصاديا
- الإصلاحات النقدية المستمرة توفر بيئة مالية مستقرة وتعزز ثقة المستثمرين
- هل تصبح "المرونة المائية" واقعا.. أم تبقى رهينة الفرص المؤجلة؟
- بعد موجة قلق ائتماني... أرباح البنوك الإقليمية الأميركية تختبر قلق المستثمرين
هل تصبح "المرونة المائية" واقعا.. أم تبقى رهينة الفرص المؤجلة؟

الغد-إيمان الفارس
في قلب منطقة تعاني من صراعات متشابكة واضطرابات سياسية واقتصادية، تبرز أزمة ندرة المياه في المنطقة العربية، ومن ضمنها الأردن، كواحدة من أخطر التحديات الإستراتيجية التي تواجه استقرار المجتمعات والدول على حد سواء.
إذ ينخفض نصيب الفرد من المياه العذبة في المنطقة لما دون عتبة الفقر المائي التي حددتها الأمم المتحدة بـ1000 م3 سنويا، ما يضع الأمن المائي والغذائي بمواجهة تهديد متزايد.
فندرة المياه في المنطقة، ليست مجرد قضية بيئية أو إنمائية، بحسب تقرير دولي حصلت "الغد" على نسخة منه، بل قضية أمن قومي وجيوسياسي، وفي ظل تداخل الجغرافيا والسياسة والمناخ، فإن الطريق إلى "مرونة مائية" حقيقية، يبدأ بإرادة إقليمية جماعية، تتجاوز السياسات الضيقة، وتبنى على الابتكار والتعاون.
ووفق التقرير الذي حمل عنوانه "الاستخدام الذكي والمسؤولية المشتركة: الطريق إلى مرونة المياه في الشرق الأوسط"، فإنه برغم تعقيد المشهد، فإن هناك حلولا قابلة للتطبيق، تتطلب دمج التكنولوجيا، والسياسات المستدامة، والتعاون الإقليمي.
وتعتمد عدة دول في المنطقة على أنهار مشتركة عابرة للحدود، ما ينتج توترات مائية تضاف لسجل الصراعات القائمة.
وتطرق التقرير إلى الحالة التي تواجهاها الأردن وفلسطين، وما يعترضها من تحديات مائية مركبة، إذ يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على جزء كبير من مصادر المياه في الضفة الغربية والجولان وجنوب لبنان، ما يؤثر على تدفق مياه نهر الأردن، ويزيد من تعقيد أزمة المياه في المناطق الفلسطينية والأردنية، لا سيما خلال فترات الجفاف.
وفي الوقت ذاته، أكد أنه لا يمكن الفصل بين أزمة ندرة المياه وتغير المناخ، لكن الأخير ليس العامل الوحيد، فضعف البنية التحتية، وسوء إدارة الموارد، والتلوث، والهدر، كلها أسباب تؤدي لاستنزاف خطر للمياه الجوفية والسطحية على حد سواء.
وفي ظل تسارع النمو السكاني والتوسع الحضري، فإن تأخر التدخل الفعّال بإدارة المياه، سيؤدي لانهيار المنظومات البيئية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما حذر منه مختصون في قطاع المياه لـ"الغد"، بخاصة إزاء تعقّد أزمة المياه في الأردن، نتيجة التغير المناخي وندرة الموارد بحيث دعوا لضرورة التحوّل الفعلي نحو إدارة مائية مرنة، تستند إلى أسس الحوكمة الفعالة والتخطيط طويل المدى على نحو جاد.
واعتبر الخبراء، بأن التعامل مع هذه التحديات، لا يمكنه النجاح دون مراجعة السياسات والتشريعات، واعتماد تقنيات حديثة، وتوسيع استخدام مصادر المياه غير التقليدية، مشيرين إلى أن الأردن يمتلك إطارا مؤسسيا وتشريعيا، يسمح بتنفيذ حلول عملية، مدعوما بإستراتيجية وطنية واضحة، لكن نجاح هذه الجهود يرتبط بمعالجة جوانب الضعف المؤسسي، كالبيروقراطية وتداخل الصلاحيات وضعف الرقابة على الاستخدامات غير المشروعة.
وشددوا على أهمية إعادة هيكلة إدارة المياه، عبر كيان مؤسسي موحد، يعزز التنسيق بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وتحديث أنظمة التحكم والربط بين مناطق الخدمة، لضمان استجابة أسرع ومرونة أعلى في حالات الطوارئ والجفاف.
كما دعوا لأهمية تطوير خطة استثمارية، تستند لتقييم فعلي لأضرار التغير المناخي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة، بما يسهم بتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التزود المائي، دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
وبخصوص السياق ذاته، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري إياد الدحيات، ضرورة تبني مجموعة مبادئ حديثة لإدارة مصادر المياه، في ظل التحديات المتصاعدة المتمثلة بندرة المياه وتغير المناخ، وتراجع مناسيب المياه في السدود، في العام الحالي أو في الأعوام المقبلة.
ولفت الدحيات، إلى أن التعامل مع هذه الظروف، لا يمكن أن يجري بطرق تقليدية، بل يتطلب منظومة إدارة مائية متطورة، تعمل على تحديث الخريطة المائية، اعتمادا على نتائج الدراسات الجيولوجية التي أجراها مكتب البحوث الجيولوجية والتعدين الفرنسي، ومعهد علوم الأرض الفيدرالية الألماني.
وكشفت هذه الدراسات، عن وجود طبقات مائية واعدة، أكانت تحوي مياها مالحة أو عذبة، يمكن استثمارها عبر مخصصات الموازنة العامة، أو بطرحها كفرص استثمارية أمام القطاع الخاص، ضمن عقود تنقيب واستخراج، تشتري بموجبها الحكومة المياه المنتجة، بما يسهم بتعزيز الأمن المائي دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
وأوضح الدحيات، أهمية تعزيز نسبة مساهمة مصادر المياه غير التقليدية في خليط المياه الوطني، بحيث تصبح المحور الرئيس للتزويد المائي، فيما تبقى المصادر التقليدية من المياه الجوفية والسطحية بمنزلة رديف إستراتيجي يعتمد عليه في حالات الطوارئ، أو مع ارتفاع الطلب في مواسم الذروة، بخاصة في الصيف، وذلك عبر التخزين بخزانات استراتيجية.
وأشار إلى أن التوزيع غير المتوازن لمصادر المياه، يستدعي ضرورة تعزيز الإدارة المركزية والمرنة للأنظمة المائية الكبرى، التي تزود أكثر من محافظة، مثل نظام مياه الديسي، ومحطة زي، وسد الموجب، مبينا أن توسيع قدرة الضخ في هذه الأنظمة سيعزز من مرونة نقل المياه بين المحافظات، مما يدعم استمرارية التزود بالمياه في حالات الجفاف أو الطوارئ بكفاءة أعلى واستجابة أسرع.
وبين الدحيات، أن القدرات المؤسسية القائمة بحاجة لإعادة تنظيم وترتيب، بخاصة بشأن إدارة مصادر وأنظمة المياه الرئيسة التي تشمل إنتاج ونقل جميع أنواع المياه، مقترحا، توحيد هذه المهام ضمن شركة واحدة تكون مسؤولة عن تطوير المصادر ومنشآت الإنتاج، أو شراء المياه من القطاع الخاص.
ويجري تأسيس هذه الشركة، لتعمل وفق مبدأ "المشتري الوحيد"، بحيث تكون حلقة الوصل المباشرة مع شركات توزيع المياه الحكومية الثلاث. مشيرا إلى أن شركات توزيع المياه، يمكن أن تعزز من مرونتها بربط مناطق الخدمة التي تعمل فيها بأنظمة توزيع مترابطة، ما يسمح بنقل المياه بين المناطق بسهولة، استجابة للظروف والاحتياجات الطارئة.
وشدد على ضرورة، أن تعمل هذه الأنظمة بنظام تحكم مركزي، يقيس الطلب الفعلي على المياه، ويدعم اتخاذ القرار الإداري بتحديد أولويات التوزيع، كما يمنح النظام مرونة في التصرف الفوري، ومعالجة الشكاوى والتعامل مع الظروف الطارئة لحظة بلحظة، بما يرفع كفاءة التزويد ويحسن الاستجابة الميدانية.
ندرة مياه مطلقة في الأردن
بدوره، حذر الخبير الدولي بقطاع المياه محمد إرشيد، من ندرة مياه مطلقة في الاردن، في ظل حصة الفرد الحالية من المياه، مشيرا إلى أن ندرة المياه وتغير المناخ، يعدان من أبرز المخاطر التي تهدد نمو الدول، لما لهما من آثار سلبية مباشرة على الوضع المائي.
وقال إرشيد إن التحديات المناخية تؤدي لانخفاض الهطول المطري، وارتفاع درجات الحرارة، وتراجع التغذية الجوفية، بالإضافة لجفاف وتملح حقول آبار، ما سيلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية، ويزيد الحاجة للطاقة اللازمة لضخ المياه بنسبة تصل لـ40 %، كما سيؤثر ذلك على الزراعة التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية.
وأضاف، أن هذا الواقع يتطلب إجراءات واضحة، للحد من المخاطر والتحول نحو إدارة مائية أكثر مرونة، بتبني سياسات وآليات وممارسات، تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، واعتماد النظم السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والإدارية في عمليات صنع القرار، المرتبط بإدارة الموارد المائية.
وأشار إرشيد لأهمية تحديث السياسات والتشريعات ذات العلاقة، كاعتماد الإستراتيجية الوطنية للمياه 2022–2040، والتي تركز على تعزيز الأمن المائي، والتخطيط بعيد المدى، ومكافحة فاقد المياه، مشددا على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الابتكار في مشاريع تحلية المياه، وتوسيع استخدام تقنيات الري المتقدمة، ومشاريع إعادة استخدام المياه العادمة، وتقوية الشراكات الإقليمية والدولية، وتفعيل منظومة الإدارة والحوكمة.
ولفت إلى ضرورة وضع خطة استثمارية عملية وواضحة، تشمل المشاريع المائية المنوي تنفيذها، على أن تستند لاحتساب كلفة الأضرار المتوقعة، نتيجة الجفاف والتغير المناخي، وما يرافقه من تأثيرات على البنى التحتية، وغيرها من الجوانب الحيوية.
وبشأن القدرات المؤسسية، قال إرشيد إن لدى الأردن قدرة مؤسسية جيدة، بحيث توجد مؤسسات ذات خبرة طويلة وهيكل إداري قائم، إلى جانب إطار تشريعي واضح، قد يتطلب بعض التحديث.
كما توجد إستراتيجية وطنية حديثة للفترة 2023–2040، وشراكات فنية قائمة مع جهات مانحة، مشددا على ضرورة معالجة نقاط الضعف التي تعيق التنفيذ الفعال، وأبرزها: البيروقراطية الإدارية، وضعف الرقابة والمساءلة، بخاصة ما يتعلق بالاستخدامات غير المشروعة، وحفر الآبار المخالفة، ونقص الكفاءات الفنية المتخصصة، والتداخل في الصلاحيات بين الجهات.
وأكد إرشيد، ضرورة تعزيز اللامركزية بإدارة المياه، ورفع كفاءة العاملين، وتدريب الكوادر الفنية، وتحسين آليات الرقابة، وزيادة الاستثمارات في مشاريع الصيانة، وتحديث البنى التحتية، والحد من فاقد المياه.
وأشار لأهمية إعداد خطة استثمارية حديثة، تستند لتقييم فعلي للبنية التحتية التي قد تتعرض للتلف أو تصبح غير صالحة بسبب آثار التغير المناخي، وجفاف العديد من الآبار، مؤكدًا أن الحاجة للطاقة سترتفع نتيجة انخفاض مستويات المياه في هذه الآبار، ما سيزيد من كلفة الضخ بما يعادل 40 %.
وحذر إرشيد، من تدهور جودة المياه الجوفية، نتيجة حركة المياه من الجزء الشرقي نحو المناطق القريبة، ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية، ومدى تأثير العجز المائي المتزايد على الأمن الغذائي الوطني.
إدارة مياه أكثر مرونة
من جانبها، رأت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، أن لدى الأردن فرصا حقيقية للانتقال إلى إدارة مياه أكثر مرونة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الانتقال، يعتمد على استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتبنّي حلول مبتكرة، وإحداث تغييرات ملموسة في سلوك الاستهلاك الفردي والمؤسسي.
ولفتت الزعبي إلى تمتع الأردن بقدرات مؤسسية كبيرة، غير أن تحديات كالنمو السكاني المتسارع وندرة الموارد المائية، تتطلب بذل جهود كبيرة لضمان نجاح هذه الحلول على أرض الواقع، بتعزيز مشاركة الجهات المعنية. مؤكدة أن فرص الأردن بتطوير إدارة مرنة للمياه، تكمن في الاستثمار بالبنية التحتية المبتكرة والتقنيات الحديثة، كمشروع الناقل الوطني للمياه، وتحسين كفاءة استخدام المياه بتقليل الفاقد وزيادة عمليات إعادة التدوير.
وأشارت الزعبي، إلى أن هذه الفرص، تشمل أيضا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، بما يسهم بجذب الاستثمارات، وتحقيق إدارة أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية.
وأوضحت، أن إصلاح ممارسات استخدام المياه غير المستدامة، برغم ارتكازه على أسس فنية، إلا أن تنفيذه يتطلب عقلية سياسية واعية، تعمل على تطوير مزيج متوازن من الاستثمارات، والحوافز، والقيود التي تفرض على أصحاب المصلحة، وفق كل سياق. مبينة بأن هذا المسار تحد حقيقي، بخاصة في ظل سياسات وسلوكيات غير مستدامة ترسخت لعقود، وفي ظل ضيق الأطر الزمنية للتنفيذ.
واعتبرت الزعبي، بأن استقرار الأردن ومستقبله، يعتمدان بشكل أساسي على توفير هذا المورد الحيوي، ما يستدعي تحركا من الحكومات ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، ومنظمات الإغاثة الدولية. مضيفة أن ممارسات استخدام المياه غير المستدامة متجذرة في النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، غير أن هناك سبيلا للحكومات لمعالجة أزمة ندرة المياه، بالتركيز على الإدارة الفعالة للمياه بالتوازي مع زيادة الإمدادات.
ورأت بأن تحسين كفاءة استخدام المياه، إستراتيجية رئيسة لبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية تسهم بالتخفيف من ندرة المياه وموجات الجفاف، بتبني حلول عملية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وحصاد مياه الأمطار، واعتماد تقنيات ري حديثة في القطاع الزراعي.
ونوّهت الزعبي بأن هذا النهج يعزز من الأمنين المائي والغذائي، فيقلل من الاعتماد على مصادر المياه التقليدية، لا سيما في ظل ما يشهده الإقليم من ارتفاع في معدلات التبخر، وفشل في المحاصيل نتيجة التغيرات المناخية، معتبرة بأن تنظيم الطلب على المياه الزراعية عبر سياسات إدارة فعالة للطلب، يشكل نقطة انطلاق ضرورية، برغم صعوبتها السياسية، مشددة على أهمية مواءمة الحوافز مع القيود.
وأوضحت، أن فرض القيود وحده على استهلاك المياه لا يكفي، بل يجب تقديم حوافز مشجعة، لا سيما للمزارعين، لترشيد استخدام المياه. مؤكدة ضرورة تقديم دعم مستمر للمزارعين الذين يستخدمون أنظمة ري موفرة، معتبرة بأن دعم المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، قد يكون أحد الحلول الضرورية، إلى جانب التوسع بالزراعة المائية والعمودية، ما يتيح استخدام كميات أقل من المياه، مقارنة بالزراعة التقليدية في الحقول المفتوحة.
وشددت الزعبي على أهمية بناء الثقة باعتبارها شرطا أساسيا للمضي قدما في مسار تحسين الأمن المائي، محليا وإقليميا، مشيرة إلى أهمية التخطيط طويل الأمد، والتعاون بين جميع الأطراف، بما يشمل تعزيز الشفافية من جانب الحكومات وزيادة وعي المواطنين. لافتة إلى دور إشراك المجتمع المدني كشريك حقيقي، وليس كمصدر تهديد، بالوصول لنتائج ملموسة، لا سيما وأن النشطاء والعلماء والأكاديميين، قادرون على تأدية دور فاعل بالحد من هدر المياه، وتعزيز وعي المجتمعات المحلية بأهمية التغيير.
وجددت الزعبي التأكيد على أن أزمة المياه في الأردن، ليست عابرة أو مرتبطة بفصول الجفاف الموسمية، بل أزمة هيكلية طويلة الأمد، تتطلب توازنا دقيقا بين إدارة الطلب وتأمين مصادر جديدة للمياه، والجهود الوطنية والتعاون الإقليمي. مؤكدة أن السيناريوهات السياسية المتغيرة في المنطقة، لا تغير من حقيقة أن الحل الأكثر واقعية، يكمن بتحديث البنية التحتية، وتحلية المياه، وإعادة استخدامها بكفاءة، وترسيخ ثقافة الترشيد.
وخلصت إلى أن الخيار لم يعد بين الوفرة والندرة، بل بين إدارة الأزمة بحكمة أو مواجهة تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الوطني.
اعتماد تقنيات ريّ ذكية
إلى ذلك، أوصى التقرير ذاته، بأهمية اعتماد تقنيات ريّ ذكية وفعالة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، وتطوير الزراعة المائية لتقليل الهدر، واستخدام الذكاء الاصطناعي بمراقبة وإدارة شبكات المياه، إلى جانب عقد اتفاقيات عادلة لتقاسم الأنهار المشتركة، وإشراك المجتمع المدني بجهود التوعية.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الدول العربية، موريتانيا فقط، تتمتع بنصيب مياه للفرد يفوق عتبة الأمان 1700 م3 سنويا، بينما تتفاقم المعاناة في دول الخليج ذات الطبيعة الصحراوية، والتي لجأت لتحلية مياه البحر كخيار استراتيجي، إذ تنتج حاليا 40 % من المياه المحلاة على المستوى العالمي.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة للعام 2023، يفتقر 50 مليونا في العالم العربي لمياه الشرب الأساسية، ويعاني 390 مليونا، أي 90 % من السكان العرب من ندرة مائية حادة.
وبرغم أن المياه العذبة المتوافرة على الأرض تكفي نظريا أكثر من 8 مليارات نسمة، لكن التوزيع الجغرافي غير العادل، والتدخلات البشرية بإدارة الموارد، جعلا من ندرة المياه أزمة متفاقمة.