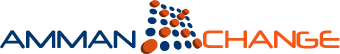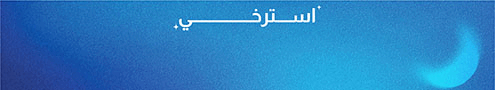المواضيع الأكثر قراءة
- إستراتيجية مستقلة للكهرباء لإنهاء حالة تشتت الرؤى وخلط الأولويات
- اقتصاديون: الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح ويحوز ثقة متنامية
- شراكة أردنية-بريطانية لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الشباب المبدع
- دعوات لتعزيز الرقابة الاقتصادية في مجلس الأمة بعيدا عن الشعبوية
- صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد الدين العام العالمي
- النتشة: تراجع الطلب على الالبسة للموسم الشتوي
- ثقافة الشراكة الزراعية بين القطاعين.. متى تردم الفجوة؟
ثقافة الشراكة الزراعية بين القطاعين.. متى تردم الفجوة؟

الغد-عبدالله الربيحات
منذ قيام الدولة الأردنية، اكتنفت الشراكة بين القطاعين العام والخاص غموضا في العلاقة، وانعداما في الثقة، لا سيما في المجال الزراعي، الذي ينبغي أن يقوم على ثنائية "المُنتِج" و"الممكّن"، وعلى التكامل لا التبعية، وعلى الرؤية لا المصلحة، بغية تحويل الزراعة من قطاعٍ مثقل بالتحديات إلى قطاعٍ قيادي للتنمية الوطنية.
ووفق خبراء زراعيين لـ"الغد"، أكدوا أنه منذ تأسيس الإمارة، احتفظ القطاع العام بموقعه كمركز للسلطة السياسية والإدارية، فيما ظل القطاع الخاص يتحرك ضمن هوامش محددة، متأثرا بمعادلة الأمن والاستقرار التي وفرتها الدولة.
وأوضح هؤلاء أن ما نحتاجه اليوم هو إرادة حقيقية لإعادة صياغة مفهوم الشراكة بين القطاعين ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي وضعت أسس التحول الهيكلي للاقتصاد الأردني، وجعلت الزراعة أحد محركات النمو الرئيسة.
وشددوا على أن إعادة تعريف الشراكة الزراعية كمنظومة تقوم على الثقة، والمسؤولية المشتركة، والابتكار، تعني أنه بالإمكان تحقيق النهضة الزراعية المنشودة، واستعادة الريف مكانته، والزراعة دورها الإستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
القطاع الزراعي عمود التنمية
في هذا السياق، أكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن القطاع الزراعي يشكل أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، ليس فقط لكونه مساهما أساسيا في الناتج المحلي الإجمالي، بل لأنه قطاعٌ يرتبط بشكل مباشر بحياة الناس اليومية وبأمنهم الغذائي واستقرارهم الاجتماعي.
وأضاف الزعبي، إن الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل منظومة حياة متكاملة تُسهم في تعزيز العدالة المكانية، وخلق فرص العمل، وتمكين المرأة الريفية، وتحفيز سلاسل الإنتاج المحلي، وهي، قبل كل ذلك، صمام أمان اجتماعي يحافظ على التوازن بين الريف والحضر، ويحد من النزوح الريفي المتزايد الذي بات يُحدث اختلالات ديموغرافية واقتصادية مقلقة في السنوات الأخيرة.
وزاد: "رغم وضوح أهمية هذا القطاع، فإن العلاقة بين القطاعين العام والخاص ما زالت تتسم بطابعها التقليدي، حيث بقيت الشراكة الزراعية مجرد شعار مكرّر أكثر منها ممارسة مؤسسية حقيقية، لافتا إلى أنه بدلا من أن تكون الشراكة أداة للتكامل والتخطيط المشترك، أصبحت في كثير من الأحيان علاقة تبعية وهيمنة، يُملي فيها القطاع العام توجهاته ورؤاه، بينما يكتفي القطاع الخاص بالاستجابة أو الامتثال لما يُطلب منه، دون أن يكون شريكا في رسم السياسات أو تقييم أثرها.
ولفت إلى انه في حالات أخرى، تأخذ الشراكة شكلا بروتوكوليا سطحيا لا يتجاوز حدود الدعوات الرمزية لبعض ممثلي الجمعيات أو النقابات الزراعية لحضور اجتماعات محدودة أو ورش نقاشية لا تترك أثرا فعليا في القرارات الإستراتيجية، وهذه الصورة النمطية تعكس غيابا لثقافة الشراكة الحقيقية التي تقوم على تبادل المسؤوليات وتقاسم الأدوار في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وتابع: "يُضاف إلى ذلك، أن القطاع الزراعي الأردني نفسه يعاني من تشظٍ مؤسسي واضح؛ إذ تعمل الجهات الفاعلة – من اتحاد عام للمزارعين وجمعيات إنتاجية وتسويقية ونقابات مهنية وغرف صناعات غذائية – في جزرٍ منفصلة، دون وجود تنسيق تشغيلي أو رؤية إستراتيجية موحدة، مبينا أن هذا التباعد في الأدوار والمصالح يؤدي إلى ازدواجية في الجهود، وهدر في الموارد، وإضعاف للقدرة الجماعية على التخطيط والتأثير.
وأكد أن العمل الفردي في قطاع يعتمد بطبيعته على الترابط في سلاسل القيمة، هو وصفة مضمونة لتعطيل التنمية وإبطاء التحول.
وقال: "من هنا، تصبح الحاجة ماسة إلى إعادة تعريف مفهوم الشراكة من جذوره، فالشراكة لا تعني مجرد تقاسم الأرباح أو تنفيذ مشروعات مشتركة، بل تعني تحمّل الطرفين مسؤولية مشتركة في تطوير السياسات الزراعية، وتهيئة البيئة الاستثمارية، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير البحث العلمي، فضلا عن تبني التكنولوجيا الحديثة والرقمنة الزراعية، والتكيف مع التغير المناخي."
وبين أن الشراكة الحقيقية تبدأ من بناء الثقة المتبادلة، وتنمو عبر تحديد واضح للأدوار، وتزدهر حين تكون قائمة على الشفافية والمساءلة وتوحيد الأهداف بين الجانبين.
ودعا إلى تحويل القطاع العام من دور "الموجّه والمشرّع" إلى دور المُمكّن والمحفّز، أي أن يركز على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية التي تسمح للقطاع الخاص بالنمو والمبادرة، وفي المقابل، يجب على القطاع الخاص أن يتحرر من ثقافة الانتظار وردّ الفعل، وأن يصبح شريكا مبادرا في صياغة الرؤى والإستراتيجيات، مساهما في الابتكار ونقل التكنولوجيا، لا متلقيا للدعم والتعليمات.
وشدد على أن تحقيق هذا التحول يتطلب إصلاحا مؤسسيا حقيقيا، يبدأ بإعادة هيكلة الاتحاد العام للمزارعين ليصبح كيانا ميدانيا قادرا على تنظيم الإنتاج وتمثيل المزارعين بفاعلية في صنع القرار الزراعي، مع ضرورة استحداث غرفة زراعية وطنية تضطلع بدور محوري في ربط الإنتاج بالتصنيع والتسويق، وتعمل كحلقة وصل بين المزارعين والمستثمرين والمصدرين، بما يعزز كفاءة سلاسل القيمة الزراعية من الحقل إلى السوق.
وزاد: "من خلال هذه الأطر التنظيمية الجديدة، يمكن بناء شراكات ذكية مع صناديق التمويل التنموي والشركات التقنية والجامعات ومراكز البحث العلمي، لتمكين المزارعين من تبني تكنولوجيا التكيف مع المناخ وتحسين الإنتاجية المستدامة، كما يمكن لهذه الشراكات أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار في مجالات الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة في الري، وإعادة استخدام المياه، والتوسع في الزراعة المائية والرأسية، بما ينسجم مع أهداف التحول الأخضر والاقتصاد المستدام".
وبين أنه لا يمكن إغفال دور التمويل المبتكر في تعزيز هذه الشراكة؛ إذ إن تبني أدوات تمويل جديدة، مثل الشراكات الربحية، وصناديق التنمية الخضراء، وآليات ضمان المخاطر، يخلق بيئة أكثر مرونة لجذب الاستثمارات الزراعية طويلة الأمد، ويخفف من اعتماد القطاع على المنح والمساعدات التقليدية قصيرة الأثر.
علاقة عضوية بين القطاعين
وقال الزعبي إن الشراكة في الزراعة ليست علاقة بين "طالب" و"مانح"، بل علاقة بين منتِج وممكّن، بين من يعمل على الأرض ومن يصوغ السياسات الداعمة له، وحين تُبنى هذه العلاقة على التكامل لا التبعية، وعلى الرؤية لا المصلحة، تتحول الزراعة من قطاعٍ مثقل بالتحديات إلى قطاعٍ قيادي في التنمية الوطنية.
وأوضح أن ما نحتاجه اليوم هو إرادة حقيقية لإعادة صياغة مفهوم الشراكة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي وضعت أسس التحول الهيكلي للاقتصاد الأردني، وجعلت الزراعة أحد محركات النمو الرئيسية، فحين نُعيد تعريف الشراكة الزراعية كمنظومة تقوم على الثقة، والمسؤولية المشتركة، والابتكار، عندها فقط يمكننا أن نحقق النهضة الزراعية المنشودة، ونُعيد للريف مكانته، وللزراعة دورها الإستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
تحليل العلاقة
من جهته رأى وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري، أن فهم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الأردن يشكّل مدخلا أساسيا لتحليل مسار الدولة والمجتمع على امتداد قرن من الزمن، فمنذ تأسيس الإمارة، احتفظ القطاع العام بموقعه كمركز للسلطة السياسية والإدارية، فيما ظل القطاع الخاص يتحرك ضمن هوامش محددة، متأثرا بمعادلة الأمن والاستقرار التي وفرتها الدولة.
وقال المصري إن هذه البنية التاريخية أفرزت صورة لرأس المال الوطني بوصفه مترددا في المخاطرة، ومرتبطا بالظروف السياسية أكثر من ارتباطه بآليات السوق الحر.
وأشار إلى أن ثقافة غير معلنة ترسخت عبر العقود، يمكن تلخيصها بمقولة "شاورهم وخالفهم"، حيث اتخذت اللقاءات بين ممثلي القطاعين طابعا بروتوكوليا أكثر من كونها حوارات منتجة.
وأضاف: "غالبا ما اكتفت الحكومات بالاستماع إلى آراء الفاعلين الاقتصاديين دون الأخذ بها في عملية صنع القرار، ما عمّق الفجوة وحوّل الحوار إلى تواصل غير متكافئ، كما رافقت ذلك مظاهر من المحاباة في إدارة العلاقة، إذ حظيت بعض الشركات أو الأفراد بامتيازات خاصة بفعل الولاء السياسي أو القرب من دوائر القرار، على حساب مبدأ المنافسة العادلة".
وأوضح أن نجاح القطاع الخاص في مراحل تاريخية ارتبط بمدى قربه من الحكومات، وهو ما قلّص من مساحة الابتكار والاستقلالية، وجعل العديد من الفاعلين الاقتصاديين أسرى لمنظومة التبعية أكثر من كونهم شركاء فاعلين في التنمية.
ورغم هذه التحديات، فإن السردية الأوسع التي حكمت التجربة الأردنية تمثلت في وحدة الشعب ومؤسسة العرش، حيث شكّلا معا ركيزة للاستقرار السياسي والاجتماعي في محيط إقليمي مضطرب، ما أتاح للدولة الحفاظ على تماسكها في مواجهة تحولات كبرى، وفق المصري.
وأكد المصري أن التحول المطلوب اليوم يتمثل في الانتقال من ثقافة "شاورهم وخالفهم" إلى "شاورهم واشركهم"، بما يعزز دور الدولة كمنظم محايد لا كوصي متعالٍ، ويحفّز القطاع الخاص على التحول من رأس مال متحفظ إلى رأس مال مبادر ومبتكر.
ويتطلب ذلك، بحسب المصري، وضع أطر مؤسسية واضحة للشراكة، قائمة على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن تكامل الأدوار بدلا من تضاربها.
توصيات لتعزيز الشراكة
ودعا المصري لتحويل مجالس الشراكة إلى منصات فعلية لصناعة القرار، مع إلزام الوزارات بمتابعة تنفيذ مخرجاتها، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإنهاء المحاباة عبر اعتماد معايير شفافة وموضوعية في منح الامتيازات والدعم.
وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة بصورة مؤسسية، بحيث تُبنى القرارات على التشاور الفعلي لا على الإملاء.
وطالب بضرورة إعادة تحديد دور الدولة ليتركز على التشريع والرقابة وضمان عدالة السوق، بعيدا عن التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد ضرورة تحفيز رأس المال الوطني عبر سياسات ضريبية وتشريعية تشجع الابتكار والمخاطرة المدروسة، وبناء آليات ثقة ومساءلة مشتركة تضمن استمرارية الحوار وتراكم نتائجه.
وشدد على أهمية تطوير استثمارات مشتركة تستهدف أسواق التصدير لحماية صغار المستثمرين في السوق المحلي، وتجنّب منافسة القطاع الخاص عبر إنشاء شركات عامة مملوكة بالكامل، حفاظا على التوازن بين الدور التنظيمي للدولة والدور الإنتاجي للقطاع الخاص.
معيقات وتحديات
من جهته، قال رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير الزراعي د. أنور حداد إن الشراكة بين القطاعين في مختلف مناحي الاقتصاد واجهت العديد من المعيقات التي أوصلت الأمور الى ما هي عليه الآن، وأهمها نقص التمويل والأعباء المالية، وصعوبة في تأمين التمويل اللازم لمشاريع ضخمة، خصوصا عندما تكون تكلفة رأس المال مرتفعة أو عندما يُطلب من المستثمر تحمل مخاطر مالية كبيرة دون ضمانات كافية.
وأضاف حداد: "كما أن الموازنة العامة للدولة لا تكفي وحدها لتمويل كل المشاريع، ما يضع عبئا على الشراكة، وأحيانا تكون المشاريع مطروحة بدون دراسات جدوى مفصلة من حيث الأثر المالي أو الاجتماعي، أو دون تحليل كافٍ للمخاطر التنفيذية، ما يؤدي إلى تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف."
وتابع: "ورغم وجود تشريعات حديثة مثل قانون الشراكة 2023 وقوانين البيئة الاستثمارية، إلا أن التطبيق العملي للقوانين، والتنظيمات الفرعية، وآليات العمل في الواقع ما زالت تعاني من ضعف التنسيق، وتغيّر السياسات، أو القصور في التوضيح بخصوص بعض البنود المهمة في العقود مثل توزيع المخاطر، وآليات فض النزاع، والضمانات، إلخ."
وأضاف إن تغير القوانين الضريبية أو الجمركية، وتقلبات أسعار الصرف، والتضخم، والتغيرات في أولويات الحكومة، وسياسات العمالة الوافدة، كلها يمكن أن تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع أو الأرباح المتوقعة، ما يجعل القطاع الخاص أكثر حذرا من الدخول في مشاريع طويلة الأجل دون تأمين الحماية الكافية.
وقال: "قد يكون هناك نقص في الخبرة في صياغة العقود المعقدة، ومتابعة الأداء، وإدارة المخاطر، والصيانة بعد الاستثمار، وكذلك تأخر الإجراءات البيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وقلة الاختصاصات الفنية، وكلها أمور تؤدي إلى تأخيرات أو غياب الفاعلية، كما أن عدم وجود مؤشرات أداء واضحة يُمكن تتبعها من قبل الجمهور أو الجهات الرقابية، يؤدي إلى تفشي الشكوك في القطاع الخاص والمستثمرين، وضعف الثقة."
وزاد: "في كثير من الأحيان، يكون القطاع الخاص مجبرا على تحمل المخاطر التي يفترض أن تشارك الحكومة في البعض منها، مثل مخاطر التضخم، وتقلبات السوق، أو تغير التشريعات، بينما لا يحصل على ضمانات كافية أو آليات حماية، وهذا يُعد عنصرا يردع المستثمرين."
وتابع: "ومن المعيقات أيضا عدم إعداد المشاريع بشكل جيد، من حيث التصميم، والجدوى، والجاهزية للاستثمار، مقارنة مع المتطلبات، ما يؤدي إلى تأخر الشراكات أو توقفها، ولذلك فإن جود قائمة مشاريع إستراتيجية محكمة أمر ضروري، لكن التطبيق غالبا لا يلبي التوقعات.
وقال حداد إن بعض مشاريع الشراكة تجمع بين أهداف خدمية واجتماعية مع أهداف ربحية، وهذا قد يخلق صراعا في الأولويات، خاصة إذا لم يكن هناك وضوح مسبق في ما يُتوقع تحقيقه من كل جانب، فالقطاع الخاص يميل إلى الربحية، بينما القطاع العام يميل إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى، اجتماعية واقتصادية، وأحيانا شعبوية.