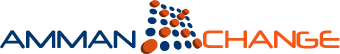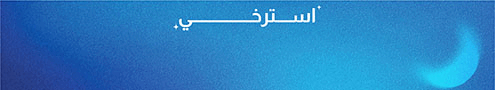المواضيع الأكثر قراءة
- "الأغذية العالمي": تقليص المساعدات للاجئين في الأردن ينذر بأزمة وتهديد للأمن الغذائي
- تحديات تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن
- "المالية" تتجه لخفض كلف الدين و"المركزي" مستمر بتعزيز الاستقرار النقدي
- الفاتورة النفطية تنخفض 4 % في تسعة أشهر
- اقتصاديون: متابعة ملكية حثيثة لضمان نجاح رؤية التحديث
- صندوق النقد: اقتصاد عُمان «صامد بقوة» رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات النفط
- 62 مليون دينار قروض لـ12.5 ألف مزارع في 2025
أسباب وحلول ارتفاع البطالة*د. يوسف منصور

الراي
ما أسباب ارتفاع البطالة في الأردن؟ سؤال بسيط لا تخلو الإجابة الموضوعية عليه من التعقيد والصعوبة. فارتفاع البطالة في الأردن ليس ظاهرة طارئة أو قصيرة الأجل، بل نتيجة تراكم طويل لعوامل اقتصادية وبنيوية وديموغرافية وسياساتية.
يعاني الاقتصاد هيكليا منذ 2010 من معدلات نمو اقتصادي منخفضة (2.5% -2.9%) لا تكفي لخلق وظائف كما أنها معدلات أقل بكثير من المطلوب لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل (والذي يجب أن يكون 5–6%) فلا يخلق سوى 20–30 ألف وظيفة سنويا بينما يدخل 70–80 ألف شاب للسوق كل عام. أيضا، إن استمرار معدلات النمو الضعيفة يرهق عوامل الإنتاج كالعمالة ورأس المال، خاصة حين يليها انكماش كما حدث في عام 2020.
يعتمد النمو الاقتصادي على قطاعات لا تُنتج وظائف كثيرة مقارنة بنموها، وتحتاج لمهارات عالية نسبيا كالخدمات المالية، الاتصالات، الطاقة، العقار، والتجارة. أما القطاعات كثيفة التوظيف هي الصناعة التحويلية، الزراعة، السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية تشهد نموًا ضعيفًا أو متقلبًا. كما يخلو الاقتصاد من الصناعات الإنتاجية الكبيرة كصناعة السيارات، والإلكترونيات، أو الصناعات الثقيلة. وهي قطاعات تخلق عشرات آلاف الوظائف المجزية في دول أخرى.
تؤثر بعض الأسباب الاقتصادية والمالية في ضعف الهيكلية الاقتصادية كارتفاع كلفة التشغيل على الشركات فالأردن من أعلى الدول في كلفة الكهرباء، والعبء الضريبي على الشركات (بسبب ضريبة المبيعات المرتفعة)، وكلفة الشحن والنقل، وكلفة التمويل (الفوائد البنكية) مما يقود الشركات الى التردد في التوسع في التوظيف حين يحصل تحسن طفيف في الاقتصاد.
يؤدي هذا الى الاعتماد على العمالة الوافدة بكثافة تعمل بأجور أقل مما يخفض حجم مغامرة التوسع على أصحاب العمل. لذا يوجد في الأردن أكثر من400–500 ألف عامل وافد يعملون بأجور أدنى من تلك التي تتطلبها العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة، الإنشاءات، المطاعم، الخدمات، الحرف، والمصانع مما يؤدي الى مزاحمة العمالة المحلية على فرص العمل الأقل مهارة، فتُستبدل العمالة الأردنية بأخرى أرخص. كما أدى ارتفاع التكاليف الى تراجع الاستثمارات الأجنبية من 2.2 مليار دولار (2006–2008) إلى أقل من 700 مليون دولار في السنوات الأخيرة وتوجه المستثمرون الى دول أقل تكلفة مثل الإمارات، والسعودية، مصر، تركيا، والمغرب.
وبالنسبة للأسباب الديموغرافية والاجتماعية فان أكثر من 64% من الأردنيين تحت عمر 30 عامًا، مما يعني طلبًا عاليًا على الوظائف، بينما القدرة الاستيعابية منخفضة. كما ينتج نظام التعليم الجامعي فائضًا في الخريجين في التخصصات النظرية (إدارة، قانون، علوم إنسانية)، ونقصًا في مهارات تقنية (لحّامين، كهربائيين، ممرضين، تقنيين، مبرمجين)، وبالنتيجة فإن 80%من الباحثين عن عمل هم من حملة الشهادات الجامعية يرفضون العمل الحرفي ويُنظرون اليه كمهنة “دونية”، ليواجهوا بطالات عمل طويلة الامد.
هناك أسباب مؤسساتية تؤدي الى معدلات بطالة مرتفعة كالبيروقراطية والبيئة الاستثمارية المعقدة، فرغم التحسن في الإجراءات لا يزال تأسيس شركة أو الحصول على ترخيص يتطلب إجراءات طويلة ومكلفة، وهذا يقلل من خلق الشركات الجديدة وقدرتها على التوسع.
ورغم وجود سياسات لتنشيط سوق العمل مثل برامج التدريب الموجه، التدريب داخل الشركات، دعم التشغيل قصير المدى، برامج التحول من قطاع لآخر غير ان هذه السياسات بحاجة الى تفعيل أوسع وأعمق مدعما بالتمويل اللازم لخفض البطالة.
كما أن عدم استقرار السياسات كالتغيرات المتكررة في الضرائب والتسهيلات، وقوانين الاستثمار، وسياسات الطاقة، تجعل آفاق المنتجين أكثر ضبابية وحذرا في التوسع في توظيف العمالة. بالإضافة هناك صدمات خارجية أثّرت على سوق العمل مثل إغلاق الحدود مع العراق وسوريا (2011–2017)مما أدى الى خسارة أسواق رئيسية صدّرت لها الصناعات الأردنية، وإغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال. أيضا، أثرت جائحة كورونا في العام(2020)على السياحة، النقل، المطاعم، العمل الحر وعمّقت البطالة وخاصة بين النساء والشباب.
نتيجة لهذه العوامل والأسباب فإن ارتفاع البطالة في الأردن سببه: اقتصاد ينمو ببطء وتكلفة تشغيل عالية واعتماد على العمالة الوافدة وتعليم غير موائم وبنية اقتصادية غير قادرة على خلق وظائف كافية لعدد السكان.
لذلك فان الحلول يجب ان تعتمد أولا على معالجة كل من هذه البنود او المسببات على حدة.
بداية، بالنسبة للنمو الاقتصادي والذي بلغ مؤخرا 2.8% يجب رفعه إلى 4.5–5% سنويًا عبر إطلاق قطاعات كثيفة التشغيل تجارب ناجحة مثل المغرب (صناعة السيارات)، تركيا (اللوجستيات)، فيتنام (الصناعات الخفيفة). فالمعادلة المركزية هي كل 1% زيادة في النمو الحقيقي (الفعّال) ستخلق 10–15 ألف وظيفة في الأردن. لاحظ ان هناك معادلة تتبع قانون اوكن وهي ان كل 2% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تؤدي الى خفض البطالة بنسبة 1%. غير ان هذه النسب تنطبق اكثر على الولايات المتحدة بسبب الاختلاف الهيكلي بين الاقتصادين، وحسب بحث قمت به مؤخرا فان 2.5% نمو حقيقي في الأردن يؤدي الى خفض البطالة بنسبة 1%، أي أن الكلفة هنا أعلى.
يجب ان يأتي رفع النمو الاقتصادي عبر عدة طرق كمضاعفة حجم الصناعات التحويلية عبر اعطاء حوافز ضريبية للصناعات التصديرية، وتخفيض كلفة الكهرباء للصناعة بنسبة 20%، بالإضافة الى إنشاء عدة مناطق صناعية لوجستية كبرى قرب العقبة والمفرق مثلا. أما فيما يخص تنشيط قطاع السياحة فيأتي عبر برنامج جاذب للطيران منخفض التكلفة، وتوجيه 100 مليون دينار سنويًا لتسويق الأردن عالميا، وتحفيز الاستثمار في الفنادق الصغيرة والمتوسطة. وتوسيع الاقتصاد الرقمي عن طريق إعفاء شركات المعلوماتية الناشئة من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، والعمل على تدريب 50 ألف شاب على مهارات تقنية قابلة للتوظيف.
لتخفيض كلفة تشغيل الشركات وأعباء التشغيل، تشمل الإجراءات عدة أمور اساسية منها تنزيل تعرفة الكهرباء للقطاعات الإنتاجية بنسبة 15% خلال عامين، وإلغاء 25% من الرسوم الحكومية والتصاريح المتكررة، وتحويل 80% من إجراءات الاستثمار إلى نظام رقمي واحد، بالإضافة الى اعتماد نظام “التصريح الصامت”(الموافقة تلقائيًا خلال 10 أيام ما لم تُرفض).
وبالنسبة لخلق سياسات نشطة لسوق العمل يوجد عدة تجارب ناجحة مثل تركيا اذ قامت الحكومة هناك في عام 2003 بدعم أجور مؤقت للفئات الشابة، اما في المغرب فتم انشاء برامج تدريب مقابل التشغيل، وفي جورجيا قامت الحكومة بتبسيط الأنظمة والتشريعات الحكومية.
لذا، لا بد من إيجاد برنامج دعم تشغيل وطني (200 ألف فرصة سنويًا) يدعم الأجور لمدة 12 شهرًا حيث تتحمل الحكومة 30–40% من راتب الموظف الأردني الجديد لتوظيف الشباب، والنساء، وسكان المحافظات، والمتعطلين لأكثر من 12 شهرًا. كما يمكن تدريب 50 ألف شاب سنويًا داخل مصانع وشركات، وإلزام الشركات الكبيرة وخاصة شركات صناعات التنقيب بنسبة تدريب لا تقل عن 5% من العمالة.
أما بالنسبة الى تنظيم العمالة الوافدة فيجب ربط تصريح العامل الوافد بالقطاع وليس المستقدم (مثل الإمارات)، ورفع رسوم استقدام العمالة الوافدة للقطاعات الممكن أن يشغلها الأردنيون، وزيادة التفتيش واستخدام نظام تتبع تصاريح إلكتروني وذلك لتحويل 40–50 ألف فرصة سنويًا من العمالة الوافدة إلى الأردنيين.
من الضروري إعادة هندسة التعليم المهني من خلال إنشاء 20 مدرسة تقنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدريب 30 ألف طالب سنويًا في تخصصات اللحام الصناعي، والكهرباء، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، والتمريض، والبرمجة. ومن الممكن ربط القبول الجامعي بحاجات السوق عبر نظام نقاط واستفتاءات مبنية على دراسات ومسوحات دائرة الإحصاءات العامة. يمكن تقديم منح دراسية حكومية وتمويلية لـ 10 آلاف طالب سنويًا لتسريع التحول نحوالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومضاعفة عدد خريجي المهن الهندسية والتقنية المطلوبة عالميًا.
لتمكين المرأة (حيث ان البطالة بين النساء تتجاوز 30.9% حسب البنك الدولي، كما ان معدل المشاركة في سوق العمل في الأردن (12-14%) يعتبر من الأقل في العالم ان لم يكن أقلها)، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية كمنح إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للشركات التي توظّف النساء بنسبة +40%، وإنشاء حضّانات في كل منطقة صناعية/حكومية، وتقديم برامج تدريب موجهة للفتيات في المناطق الريفية، ودعم النقل من وإلى مواقع العمل.
لتنمية المحافظات وتعظيم مشاركتها يجب التحول نحو خلق عناقيد متخصصة تدعمها صناعات متكاملة وداعمة لبعضها البعض كأن يتخصص عنقود مأدبا في السياحة، والمفرق في اللوجستيات والصناعة، والكرك في الصناعات الغذائية، الخ.. ومن الضروري إيجاد صندوق استثمار للتشغيل في المحافظات برأس مال 300 مليون دينار يمول مشاريع صغيرة ومتوسطة.
من المهم ايضا القيام بإصلاحات أفقية كإصلاح بيئة الأعمال، وتحديث قانون العمل، وتوسيع الحوافز للمستثمرين، وتقليل الضرائب غير المباشرة تدريجيًا، وتسريع القضاء، وإيجادج مشاريع لشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تشغيلية في عدة محاور كالنقل العام، والبنية التحتية، والطاقة، وإدارة وتدوير النفايات، وغيرها.
نعم، إن تخفيض معدلات البطالة يتطلب تغييرا جريئا لهيكلية الاقتصاد الأردني ومعالجة اختلالات عديدة مما يجعل هذا الهدف مكلفا يتطلب فترة غير قصيرة من الزمن في رحلة تعتمد الوضوح، الاستمرارية، والثبات.
حمى الله الأردن...